۱۳۶ نتیجه برای نوع البحث: Research
علی احمدی،
المجلد ۴، العدد ۳ - ( ۳-۱۴۴۴ )
الملخّص
إنّ "الشخصية" من الأركان الرئيسة المشكّلة للنصّ القصصي. وتعدّ "العاملية" أي "فعل الشخصية" من الاتجاهات المهمة في هذا المجال، فتوظيف كلّ شخصية في القصة يتطلّب دقة وإتقاناً خاصاً. و كلّ كاتب بإمكانه أن يقيم علاقة عميقة مع قرّائه من خلال توظيفه السليم للشخصيات ويمضي بالقارئ إلى بطن القصة ويحثّه على متابعة الرواية حتّى النهاية. يسعى هذا البحث عن طريق المنهج الوصفي-التحليلي أن يلقي الضوء على شخصيات رواية "المستنقع" للسحّار وهي إحدى روايات الكاتب الواقعية وذلك على أساس نظرية غريماس في مجال "الأدوار العاملية". إنّ غريماس طرح نظريته في مجال الرواية متأثّراً بنظرية "بروب". بما أنَّ نظرية غريماس قابلة للتطبيق في جميع الأنماط الأدبية تقريباً، من هنا نموذجه لدراسة الأدوار العاملية في الشخصيات القصصية تشتمل على ثلاثة نماذج ثنائية وهي: «العامل/الهدف»، «المرسل/المعمول» و «المساعد/المعارض». يظهر لنا من خلال النتائج الّتي تمّ استنتاجها على ضوء المنهج الوصفي-التحليلي بأنّ شخصيات الرواية يعانون من مفارقة كبيرة بالنسبة إلى القيم (الحبّ والخيانة، العفو والأنانية، الانتقام وطلب الخير، المستنقع والطريق الصواب). إنّ فؤاد -بناء على نموذج غريماس حول العاملية- يعيش في فضاء المجتمع التقليدي في مصر، وهو يمضي في سبيل أهدافه بنشاط ودون توقف أو جمود، ويلعب دوره في العامل القصصي ويجعل المكونات الأخرى لهذا النموذج تسير نحو طريق التفاعل.
الهام قربانی، عباس عرب، مرضیه آباد،
المجلد ۴، العدد ۴ - ( ۵-۱۴۴۴ )
الملخّص
تعد الهوية التي تبين علاقة الفرد الديالكتيكية مع العالم الخارجي، من نماذج جودة السلوک بين آحاد المجتمع. شيلدون سترایکر وهو من السوسيولوجيين يری الهوية ذات علاقة مع الأحاسيس و يعتقد بأن في الهويات الموجودة في الشخص تبرز هوية يجرب الشخص أحاسيس إيجابية أو سلبية صعبة مع الأدوار، والأفراد وکذلك الوضع الاجتماعي المتناسب معها. نظرا بأن الأدب السردي الذي هو المجال الواسع لصدی الهوية الاجتماعية، فرواية «وطن من زجاج» لمؤلفها ياسمينة صالح الکاتبة الجزائرية والتي تتمحور حول أسئلة الهوية في إطار الأدوار الإجتماعية المتعددة، تجسد مجموعة متداخلة من تأثيرات المجتمع الجزائري وتأثراته في اختيار الهوية لبطل الرواية. هذا المقال يقصد معالجة البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري والأحاسيس المنتجة منها والتي لها دور في إبراز الهوية، مستخدما طريقة تحليل المحتوی والقراءة النصية بناء علی نظرية سترايکر. تُظهر نتائج البحث بأن بطل الرواية حصل علی مفاهيم عاطفية مشترکة من جراء العلاقة المؤثرة مع الطبقة المثقفة في المجتمع کمعلمه في المدرسة و تجربته الجامعية والزملاء الصحفيين الذين يزيدون في وعيه الاجتماعي. وهذا الأمر أدی إلی التزامه بالمجموعات المشترکة ليقاد إلی الأدوار الاجتماعية منها الصحافة والتي تتناسب مع هويته البارزة بوصفه «شرطيا اجتماعيا». و کذلك ما يلفت النظر في ترکيز الهوية جودةً، هي الأوضاع المتعددة التي کانت قد أثرت علی إعادة إنتاج أحاسيس بطل الرواية.
سمیه یاوری، حسن مجیدی، حسین شمس ابادی، حسین قدرتی، مهدی خرمی،
المجلد ۴، العدد ۴ - ( ۵-۱۴۴۴ )
الملخّص
على محاذاة عصر التكنولوجيا وانفجار المعلومات، أصبحت الدراسات بتعددية التخصصات أكثر أهمية. أصبح رأس المال الاجتماعي في العقود الخمسة الأخيرة مفهوماً رئيساً في النظريات الأكاديمية والأبحاث العلمية. فمن هذه الاختصاصات والدراسات، هو رأس المال الاجتماعي في الأدب. الأدب هو مرآة يمكن من خلالها ملاحظة خصائص العلاقات الاجتماعية لأفراد المجتمع. يهدف هذا البحث المتواضع إلى الكشف عن مظاهر رأس المال الاجتماعي في رواية سيدات القمر لـ "جوخة الحارثي"، كاتبة عمانية معاصرة ومن مواليد ۱۹۷۸ في عمان، التي نالت على جائزة "مان بوكر" العالمية، لرواية "سيدات القمر" عام ۲۰۱۹ م. تتمحور الرواية حول الأسرة والقضايا الاجتماعية بسرد حياة ثلاث شقيقات وأسرتهن والتطورات الاجتماعية في عمان. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي - التحليلي مستعيناً بطريقة تحليل المضمون. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: بروز موضوعات وقضايا متنوعة في ميدان ظاهرة رأس المال الاجتماعي وكافة مؤشرات المعيار وتطبيقاته، ولاسيما في مجالات كالمشاركة والتعاون، والتضامن، والدعم الاجتماعي، مقارنة بالمؤشرات الأخرى.
توفیق رضاپورمحیسنی، حسین مهتدی، ناصر زارع، سید حیدر فرع شیرازی،
المجلد ۴، العدد ۴ - ( ۵-۱۴۴۴ )
الملخّص
يعد مفهوم النسق من المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها النقد الثقافي المتعامل مع ما هو مستهلك جماهيرياً، إذ يهتم هذا النقد بالوظيفة النسقية في النصوص والخطابات، ويستقصي اللاوعي النصي مقوّضاً اللغة البلاغية التي تتراوح بين تفكيك المشاكل الاجتماعية بلغة أكاديمية متعالية عن الواقع وبعيدة عن المشاركة في حلحلتها، وبين الانغلاق على الجمال البلاغي دون تجاوزه وإهمال أسئلة الفعل والتأثير. وهذا النسق قد يكون في الأغاني أو في الأزياء أو الحكايات والأمثال مثلما هو في الأشعار والقصص والروايات والألحان الشعبيّة المسجّعة وغيرها من الفنون. فكل هذه العناصر يتخفى بين ثناياها الجمالي البلاغي نسق ثقافي ثاوٍ في المضمر، وهو ليس في وعي الكاتب في الغالب، لا يدركه الناقد إلا باستخدام أدوات خاصة. ويعبر دائماً على نقيض المضمر البلاغي ومن خلاله سيبدو الحداثي رجعياً. حاولت هذه الدراسة، بالاعتماد على المنهج الوصفي – التحليلي وعلى ضوء النقد الثقافي الذي يبحث في الأنساق الثقافية المضمرة، رصد وتحليل نسق الفحولة المضمر في رواية "مدن الملح" للروائي عبدالرحمن منیف إذ تعد الروایة من أهم النصوص الناقلة للأنساق، وأيضاً تتناول بعض الأفكار والمفاهيم وطرح بعض التأمّلات. ولقد درسنا في المحاور الفرعية تمثلات نسق الفحولة في هذه الرواية التي أخذت صوراً عدّة مثل: القوة، وإنجاب الذکور، ودونیة المرأة وفوقية الرجل، والأنوية أو تضخیم الأنا. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: أنّ عبدالرحمن منيف بوعي منه حينا، وعلى غفلة أحياناً، جعل نسق الفحولة وراء النسق الجمالي والأدبي، لذا لا تحتفل روايته بالمركزي فحسب بل صار الهامش محط نظره كذلك.
الدکتور مجتبی بهروزی، الدکتور علی اصغر حبیبی، السیدة منا مرتضوی نسب،
المجلد ۴، العدد ۴ - ( ۵-۱۴۴۴ )
الملخّص
تُعَدّ فانتزية أدب الأطفال والمراهقين من التقنيات التي يعتمد عليها الكُتّاب للترفيه عن هذه الشريحة وسدّ حاجاتها الضرورية التي تتمثّل في تعزيز الخيال، والحثّ على التحلّي بمكارم الأخلاق، والشجاعة والحكمة. فمن القصص التي تتميز بوجهتها الفانتزية قصة "بدر البدور"، وهي قصة شعبية يكاد لايخلو منها أدب من الآداب. تستعرض هذه الدراسة وبالاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي وعلي أساس المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن تستعرض الفانتازيا الفوقية في قصة "بدر البدور" العربية والفارسية، وتقارن بين نتاجات أربعة كتّاب من الفرس والعرب، وهم: فضل الله مهتدي وميترا بياتي (إيرانيّان)، ويعقوب الشاروني وكمال الكيلاني (عربيّان)؛ فمن خلال هذه االمقارنة تتمّ دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين أنواع الفانتازيا الفوقية، مثل القوطي، والتربوي، والحيواني، والجني، والبحثي، والتمثيلي وغيرها. إنّ نتائج البحث تشير إلى أنّ القصص الفارسية في مجموعها هي أكثرُ خياليّة من القصص العربية، إذ تفوّقت عليها بنسبة۷/۴ بالمئة في توظيف أنواع الفانتازيا الفوقية؛ كما أن قصة "ماه پيشوني الفارسية" المبنية على الفولكلور قد ورد فيها ۶۶ نوعاً من الفانتازيا، فلذا اتصفت بأكثر القصص خيالية من بين القصص المدروسة.
علاء فليح حس الزهيري، فرامرز میرزایی، هادی نظری منظم، کبری روشنفکر،
المجلد ۴، العدد ۴ - ( ۵-۱۴۴۴ )
الملخّص
إنَّ الخطاب مجموعة ملفوظات تحدد أنماط السلوك، وتؤثر على الحياة المجتمعية سلباً وايجاباً، فلذلك توغّل خطاب السلطة في جميع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية وحتى القضايا النفسية، وبما أنّ الرواية عالم سردي يستحضر ما ظهر من واقع المجتمع وما خفي منه، فلا يمكن تحليلها بمعزل عن خطاب السلطة. ولخطاب السلطة حضور متميّز في التشكيل السردي في روايات حميد العقابي خاصة في تشكيل البنية الفاعلية؛ لأنها الأكثر تأثيراً في نظام السلطة وخطابها المهيمن. ويحاول المقال البحث عن أهم مميزات السلطة في روايات حميد العقابي، وتأثر الشخصيات الروائية المختلفة بخطاب السلطة في هذه الروايات. وقد فرضت علينا مسألة الدراسة الاستعانة بالمنهج الوصفي-التحليلي، بشكل عام، والمنهج البنيوي التكويني كمنهج نقدي لتحليل الخطاب الروائي، معتمداً على أدوات الاستقراء والاستنباط والتفسير. وقد أختيرت روايتا "أقتفي أثري" و"الفئران" لمعالجتهما ضمن إطار نظام السلطة السياسي والظواهر المهميمنة وفق ما تقتضيه الشخصيات لاستخلاص النتائج وفهمها. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمّها: إنّ السلطة لم تؤثّر على الأوضاع المعيشية فحسب بل أثرت على السلوكيات والأطباع وصار هذا الخطاب متفشياً في نسيج المجتمع، وكانت الشخصيات المنهزمة أكثر فاعلية من الشخصيات المنتمية في الروايتين، وحاول العقابي أن يصوّر ما في السلطة من تأثير سلبي على الشخصيات الروائية كالتشظي وضياع الهوية والأزمات النفسية الحادة.
دانشجوی دکتری زینب دريانورد، دکتر محمد جواد پورعابد، دکتر رسول بلاوی، دکتر علي خضري، دکتر هيثم عباس سالم الصويلي،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
التبئير في السرديات والمحكي السينمائي قد يعني تحديد زاوية الرؤية، إذ يشكّل دوراً مهمّاً في سرد الأحداث عبر تَعدّد مظاهر البؤرة، وقد يتجزّأ إلى التبئير الصفر والتبئير الخارجي والداخلي والأبعاد البؤرية للصور المرئية، التبئير في السرد الروائي هو تحديد موقع السارد أو الشخصية الروائية، والزاوية التي ينقل لنا من خلالها الأحداث، أمّا السرد السينمائي فتتبنّى الكاميرا السردية فیه وجهة نظر الشخصيات على حده، فتُنتج بعض المفاهيم والأفكار الإيديولوجية في التجربة السردية السينمائية، كما أنّ هذه الأدوات السينمائية تُعزز قدرة المتلقي على إدراك المحكي فيصبح التبئير أداةً دراميةً وهذا العنصر انطبق تماماً على رواية "القنّاص" لزهران القاسمي حيث وزّع زوايا النظر في أماكن عدّة من القرى العمانية بواسطة المنظار الذي يسجّل به بطل الرواية صالح بن شيخان زوايا الرؤية.
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي- التحليلي، للوقوف على آليات اشتغال التبئير في المحكي الروائي وتحديد أنواعه ومظاهره في رواية "القنّاص" وفقاً لعناصر البناء الصوري. تهدف هذه الدراسة للكشف عن دلالات التبئير البصري وكيفية ايصال المتلقي لإدراك شمولي من زوايا الحكاية، وتبيين مواقع هذه الزوايا حسب الشخص السارد سواء كان الراوي للمشاهد المرئية أو الشخصية الروائية. من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أنّ التبئير السينمائي يتشكّل بتداخل الكاميرا والشخصية الساردة وتفاعل المتلقي للمشاهد المصوّرة، لذا نرى أنّ السرد السينمائي له قابلية هضم التبئير المرئي لاعتماده على المجال الكلامي والصوري في الرواية المذكورة، كما أنّ التعالق بين الصورة المرئية والشخصيات الساردة في الرواية ينتجان نمطاً متنوعاً في إيصال وسرد المعلومة، وعلى هذا الأساس يدور البحث حول محورين أساسيين هما؛ التبئير البصري والبُعد البؤري للتبئير.
صادق هاشمی امجد، مهدی خرمی سرحوضکی، حسن مجیدی، سید مهدی نوری کیذقانی،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
اشتهر غریماس بإحدی البرامج السرديّة الهامّة أي النموذج العاملي الذي یُعتبر نموذج لتحلیل الحکي ویتعلّق بالنصوص الحکائية ویستهدف تجسید المسار لدی الشخصیات وتسجیل الأعمال والسلوکیات. یُقصد بالعامل کل ما له تأثير في إغناء الأحداث وازدهارها سواء أکان شخصيّة حیّة أو جماداً أو حیواناً أو فکرةً أو شيئاً له قوّة فعّاله ومؤثرة ضمن عالم النص السردي. یعتمد النموذج العاملي إلی ستة عوامل وهي: الذات، الموضوع، المرسِل، المرسَل إليه، المساعد، والمعارض. تأتي هذه العوامل في ثلاث روابط متمثّلة في الرَّغبة والتّواصل والصّراع. لقد سلّطنا الضوء في هذه الدراسة علی إحدی النصوص السرديّة أي المقامة السمرقندیّة للحريري وفق المنهج الوصفی-التحليلي بهدف معرفة عوامل إثراء النص وازدیاد تأثیره فی المتلقّي. والغاية من هذه الدراسة هو لزوم العودة إلى التراث وماجمّعه من نقاط مثيرة وما اشتمل عليه من براعةٍ فائقةٍ تتطلّب دراستها وإحياء اعتبارها الثّقافي والتاريخي. ومن أهمّ ما توصّلنا إلیه من نتائج أنَّ النموذج العاملي في التحليل السردي للمقامة السمرقندیّة کان قابلاً للتطبیق من خلال العلاقات المزدوجة بين العوامل کما توجد بعض العوامل المشترکة بين الترسيمات العاملية لهذه المقامة. کما أنّ تطبيق النموذج العاملي علی المقامة المذکورة قد ساهم في استخلاص المعنی من البنية السردية. وأدّت العوامل أکثر من دور في علاقاتها، فقد تکون حيناً ذاتاً أو مرسلاً وحيناً مرسلاً إليه، حسب تطوّر الحالات والتحوّلات في المقامة.
حيدر محلاتي، مروة الرکابي،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
فهد محمود الأسدي (۱۹۳۹-۲۰۱۳م) کاتب وقاص عراقي أبدع روايات ومجموعات قصصية تناولت المنحی الواقعي من الحياة الاجتماعية في العراق وخاصة حياة الناس في الأرياف. وقد أتقن الروائي حبك قصصه بأسلوب فني آسر يجذب المخاطب من خلال بنية قصصية متماسکة وعبارات ذات صور بلاغية تتناغم بتشبيهاتها ومجازاتها واستعاراتها الموحية. وهذه الدراسة تهدف إلى إبراز جمالية الصورة الفنية في هذه الروايات وإظهار ابداعات الروائي البيانية المتمثلة في روعة التشبيهات وبلاغة الاستعارات المستخدمة في النص القصصي. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي في محاولة لاستکشاف الإطار العام للصورة الفنية في مجموعات الأسدي القصصية، والإحاطة بالمميزات السردية التي اتضحت من خلال استعمال الروائي أغراضاً بلاغيةً موحية کالتشبيه والاستعارة والکناية لتضفي جماليةً مضاعفة وتقبّلاً ملموساً من قبل المتلقي. ورکّز هذا البحث في تحليله علی أعمال الأسدي الخمسة، وهي: رواية «الصليب؛ حلب بن غريبة» ورواية «دارة الإحسان» والمجموعة القصصية «عدن مضاع»، والمجموعة القصصية «طيور السماء»، والمجموعة القصصية «معمرة علي». وهذه الإبداعات السردية جميعها تصوّر الواقع الاجتماعي المرير الذي کان يعيشه الإنسان الجنوبي في العراق. ففي الرواية الأولی جسّد الروائي مظاهر الظلم والمعاناة التي کان يفرضها نظام الإقطاع علی الفلاحين والطبقات الضعيفة الکادحة، فراح يدعو من خلال دعوة غير مباشرة عن طريق هذه الرواية إلی نبذ جميع أنواع القهر والاستبداد والاضطهاد. أمّا الرواية الثانية فهي تمثّل العادات الاجتماعية السائدة في جنوب العراق بکل ما تحمل من معتقدات وخرافات وتقاليد عرفية لا يقبلها العقل السليم. وتعد هذه الرواية صورة حقيقية لتناقضات المجتمع الريفي وصراعه المستمر بين القديم والحديث. وتأتي المجموعة القصصية الثالثة لتبيّن بصريح العبارة التمايزَ الطبقي بين شرائح المجتمع الواحد، ومدی خطورته علی حياة الناس وتداعياته الکارثية التي تفضي إلی شرذمة الناس وتشتتهم. أمّا المجموعة الرابعة فقد تناولت قضايا الإنسان وهمومه الاجتماعية، وبينما جاءت المجموعة الخامسة لتنقد فقدان الوعي والجهل المستشري بين طبقات المجتمع المتخلف. ومن أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة: إنَّ الأديب الأسدي تعامل مع نماذجه القصصية بعفوية فنية خالصة معبّراً عنها ببيان سهل ممتنع ضمن دائرة التأويل واستکشاف بواطن الأمور من خلال تحليل ظواهرها الجلية. ولم يقحم الکاتب نفسه في مبالغات مفرغة وتهويلات لفظية طنانة تُخرج النص من جريانه الانسيابي وطاقاته المحتشدة، بل کان مُسايراً ومتناغماً مع لغة الخطاب وبناء السرد الفني.
صلاح الدین عبدی، اکرم ذوالفقاری،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ التفکيکية من الاتجاهات النقدية لما بعد الحداثة وزعیمها جاك دریدا الفرنسي، الجزائري المولد، وهي لیست منهجاً ونظرية عن الأدب لکنّها استراتيجية في القراءة وذهبت إلی لانهائية القراءات في ظل غیبة مرکزية النص ومقصدية المؤلف لتستبدلها بمقصدية جديدة وهي القارﺉ. هذه الاستراتيجية الجديدة التي قام بها دریدا مثل ثورة کوبرنیکوس في القرن السادس عشر في علم الفلك والنجوم. واعتقدت بأنّ اللغة بالنسبة إلیها مراوغة وغامضة وشيء غیر ثابت ولایمکن الاعتماد علیها ويخلقها القارﺉ عن طریق القراءة. وأهم المصطلحات في هذه الاستراتجية هي الکتابة، والاختلاف والإرجاء، والانتشار والتشتت، والأثر. يهدف هذا البحث إلى تحليل إحدى قصص زکریا تامر الکاتب السوري القصيرة المسماة "یا ایّها الکرز المنسي" من مجموعة "دمشق الحرائق" وإلی إثراء قرائتنا للنصوص الأدبية ومساعدتنا علی رؤية الأفکار المهمة والعميقة والتعرف على الاستراتيجية التفکيکية في النص وشرح ووصف أهم مصطلحات جاك دريدا وتطبيقها على نص عربي من المنظور التفکيکي وتقديم نموذج لتحليل النصوص بهذه الإستراتيجية الجديدة ورفض رؤية الذين یرونها غیر مناسبة في مجال الأدب واللغة. ومنهج البحث هو الوصفي -التحليلي. أمّا بالنسبة إلى ضرورة البحث وأهمیتها فهي فتح بوابة جديدة أمام عالم المعاني الواسع الموجود في النص، ولكن لم يتم عرض ذلك بسبب حصره في إطار بنية الجملة. وأهم النتائج التي وصلت إلیها المقالة هو اختلاف الدوال وتأجيل المعني بسبب تشتتها في النص وبعثرتها في کل زوایا النص والاستفاده من خارج النص. والثنائية الضدية أكثر ترداداً في القصة البراءة والانحطاط وإن ّالإيديولوجية التي تريد إلقائها هذه القصة القصيرة ضمن استراتيجية التفکيك من حیث قرائتنا هي الرفض والخروج من الأسر.
الدکتور سجاد فرخی پور، الدکتور نورالدین پروین،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ النظام المعقد للقواعد العربية ودلالتها متعددة المستويات على بناء الجملة جعل كتابة هذه اللغة وترجمتها أمراً صعباً. وفي الوقت نفسه، أصبحت ترجمة النصوص الأدبية إلى اللغة العربية أكثر صعوبة بكثير بسبب سماتها الجمالية وقدراتها الأدبية على المستويات الصرفية والدلالية والنحوية والتداولية والاختلافات الدلالية في البنية الفوقية والبنية التحتية، بحيث أصبحت دقة الترجمة وجودتها لا يمكن تتبعها في هذه اللغة من خلال المناهج والأساليب الشائعة في بعض الحالات. ومن هذه النقاط المفقودة في تقييم الترجمة العربية الوظائف الفكرية المبنية على النحو والدلالة، والتي تقوم على تفاعل هذين المستويين اللغويين تخلق معنى جديداً، نظراً لقلة اهتمام المترجمين والاعتماد على مناهج تميل إلى الحفاظ على البنية والمعنى، ومن ناحية أخرى فإنّه يسبب انهيار الدلالة وانقطاع في الكلام. تقوم هذه المقالة من خلال منهج تحليل المحتوى وبالإعتماد بإطار تقييم الترجمة المبتكرة من اللغويات الوظيفية المنهجية لهاليدي بدراسة الانهيارات الدلالية والفكرية المبنية على البنية في الترجمة العربية للرواية "النبي". ولهذا الغرض، وباستخدام الإطار النظري التطبيقي، تمّ تحقيق العينات الإنجليزية والعربية من الرواية المذكورة بناءً على تراجع أو تحسين الوظائف الفكرية. أظهرت نتائج هذه الدراسة أنّه على الرغم من نقل الوظائف الفوقية للتفكير بشكل صحيح في ترجمة معظم النصوص إلى العربية، لكنّها تواجه انهيار الوظائف الوصفية في العينة المترجمة استخداماً لأساليب نحوية ومعجمية غير مناسبة. نظراً لأنّه لايمكن اكتشاف هذه التحديات من خلال استخدام أساليب تقييم الترجمة الشائعة؛ تعتبر هذه الدراسة مفيدة من الناحية النظرية والتطبيقية لمدرسي اللغة والباحثين في الترجمة واللغويات التطبيقية والمترجمين.
عاطفه بازیار، شهریار همتی، علی سلیمی، تورج زینی وند،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ المدينة الفاسدة أو "الديستوبيا" إحدى المضامين الّتي نشهدها في الآثار الأدبية. إنّ هذا الاتجاه يقع في النقطة المضادة للمدينة الفاضلة الّتي كان يأمل بها الشعراء والكتّاب منذ الزمان القدیم. يتطرق الأديب في الأدب المرتبط بالديستوبيا أو المدينة الفاسدة-بصورة مركزة- إلى بيان التأثيرات المخربة للمظاهر السياسية، والاجتماعية والصناعية. في الواقع، يعدّ هذا الأدب، مرآة تعكس القسم المظلم من المجتمع الّذي يعاني من البؤس والشقاء. وبما أنّ الرواية تنبعث من قلب المجتمع والحوادث الطارئة عليه؛ فإنّ هذا العنصر له انعكاس أوسع مقارنة مع العناصر الأدبية الأخرى في الرواية. وتحوّل إلى موتيف مكرر في هذه الرواية. إنّ "أحمد سعداوي"؛ الروائي العراقي المعاصر رسم لنا لوحة واضحة المعالم حول الحياة في بغداد وذلك من خلال روايته الشهيرة "فرانكشتاين في بغداد" وقد نظر فيها بنظرة مفرطة في التشاؤم بالنسبة إلى واقع حياة الإنسان في العصر الحديث. وقد صوّر لنا الكاتب في هذه الرواية، التأثيرات الرهيبة للأطر السياسية والاجتماعية على مستقبل حياة البشر وخاصة الشعب العراقي. يظهر لنا من خلال نتائج البحث بأنّ احتلال العراق على يد أمريكا والحوادث المريرة والعصيبة الّتي تلت ذلك، تسبب في ظهور وطن يملأه الفوضى والدمار. إنّ الرواية صورة مفزعة لظروف هذا المجتمع البائس ومظاهر المدينة الفاسدة تكشف عن نفسها -وبصورة رهيبة- في مواضع متعددة من الرواية. هذا البحث وفقاً للمنهج الوصفي-التحلیلي یقوم بدراسة ظواهر الدیستوبیا مثل الضلال والانحطاط الأخلاقي، الاستغلال من ناحية المجرمين، الحرمان من نعمة الأمن، الفوضى، العنف، وزوال مقومات الحياة السلمية والهجرة القسرية. صورة مفزعة لمجتمع تحوّل إلى جسد مفكك جراء الأحداث المريرة الّتي عانى منها إثر جبر الزمان. إنّ هذه الرواية تحمل معها كافة مكونات العمل الأدبي الذي يندرج ضمن الواقعية السوداء.
أستاذة کبری روشنفکر، نضال جاتول، هادی نظری منظم، مها هلال محمد،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
يعرف التناص بأنه الصوت المتعدد ذلك لأن كل نص هو في كنهه لوحة فسيفسائية مكونة من الاقتباسات عن نصوص أخرى. ومن هذا المنطلق يكون النص محض إعادة إنتاج لخبرات تراكمية سابقة، جمعت والتحمت في البناء النصي الجديد الذي نهض في هيكليته على أساس من نصوص سابقة متباينة ومتعددة ومتنوعة المشارب. ومن هنا يكون كل نص تناصا بصورة مطلقة، ذلك أن النص يبرز في عالم يغص بالنصوص (نصوص قبلية، ونصوص محيطة به، وأخرى حاضرة فيه)، واستراتيجيته المحورية هي الهدم والتفكيك بغرض إعادة البناء. یهدف هذا البحث دراسة تجليات التناص في الخطاب السردي لقصص مختاره عن القاص العراقی علي السباعي حتی یستنتج بان أبرز أنماط التناص التي يمكننا تمييزها في خطاب السباعي السردي في المجموعات القصصية المختارة (عينة البحث) نمطان رئيسان؛ الأول تناص ذاتي حصل مع نصوص الكاتب عينه، والآخر خارجي تفاعل فيه خطاب الكاتب السردي مع نصوص خارج حدود إبداعه الشخصي.
منیر زیبائي،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ العنوان هو العتبة الأولى للدخول على عالم النص أو فضائه الرئيس، ومن الناحية الأخرى، إنّ دلالة العنوان تعد من أهم المباحث اللغوية والدلالية التي تتركز على نقد العنوان، سواء في مجال الشعر أو الرواية، نقداً دلالياً؛ بحيث يؤدي هذا الأمر إلى الشفافية في المعنى والمفهوم لدى القارئ أو المتلقي. ويعد نجم والي أيضاً من الرواة العراقیین المعاصرين، والذي له يد قصوى في كشف الحقيقة الاجتماعية عبر استخدام عناوين روائية دقيقة لرواياته، بحيث إن لكل عنوان رواية دلالة على الحقائق الاجتماعية والثقافية أو السياسية. وفي هذه الدراسة، ومن خلال الاعتماد على المنهج الوصفي- التحليلي نهدف إلى تسلیط الضوء علی ماهية دلالة العنوان ومستوياتها المتجلية في المستوى المعجمي، والمستوى الدلالي، والمستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، وتطبيق هذه المستويات على عناوين نجم والي الروائية، واستقصاء دلالاتها ومؤشراتها المعنوية. ومن النتائج التي توصل إليها المقال هي أن نجم والي لم يختر عناوين رواياته دون وعي، بل قصد من خلال اختيارها مقاصد خاصة، ومن جهة أخرى، إنها ترشدنا إلى قضايا ومفاهيم اجتماعية في العراق.
محمد نادری، اکرم روشنفکر، فرهاد رجبی،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ الرواية باعتبارها نمطاً سردياً يعتمد على تقنيات متنوعة في الكتابة، تتمتع بكامل القدرة على التحليل وذلك على ضوء النظريات التي تحدّثت عن عناصرها وكيفية توظيفها. من هذا المنطلق، عمل جينيت على إكمال إجراءات النقاد البارزين في بيان وظائف الزمن الروائي وقدّم نموذجاً بنيوياً متميزاً يمكن أن يكون -إلى جانب عنصر المكان- أرضية خصبة للدراسة والبحث. تتطرق هذه الدراسة عن طريق المنهج النقدي اللغوي الجينيتي إلى دراسة بنية الزمن في رواية "اسكندرونه" لفضل مخدر. إنّ الروائي اجتهد من خلال اعتماده على أسلوب الحوار بين الراوي-البطل والشخصيات الفرعية، أن ينظّم النصّ الروائي بناء على معدّل السرعة المعيارية التي نادى بها جيرار جينيت. ومن خلال توسّله إلى الماضي، يقيم نوعاً من التوازن المطلوب بين ذكره للأحداث والأبطال الثانويين في الزمن الضائع. مع ذلك، لم يختصر الكاتب على اعتماد بنية جينيت الزمنية؛ وقد وظّف أحياناً أسلوبي الحذف والتلخيص؛ لكي يمنح روايته سرعة أكبر أو يعتمد على أنواع الوقفات للحدّ من سرعة الزمن في الرواية ويقودها إلى السرعة السلبية. وقد تبيّن لنا من خلال نتائج البحث بأنّ "فضل مخدر" اتخذ أقصى درجات الزمنية في روايته "اسكندرونه" على ضوء نموذج جينيت. وإنّ الرواية تتمتع بنوع من النظم والترتيب الزمني الذي قام به الراوي-البطل؛ ليس هذا فحسب، بل يعاني الراوي نفسه أيضاً بالتشويش الزمني الّذي ينتهي به المطاف إلى الزمن الماضي. مع ذلك، فإنّ قمة إبداع الرواية تتمثّل في النظرة المتميزة بالنسبة إلى المستقبل؛ وهي نظرة أودعها الروائي في النهاية المفتوحة لرواية المقاومة. ويبدو أنّ عقربة الزمن في "اسكندرونه" تتراوح -على أساس نموذج جينيت- ما بين السرعة المعيارية والسرعة السلبية.
شاكر العامري، علي شهرياري،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
تعد الشخصیة من العناصر الرئیسة في الروایة بشكل عام وفي النص المسرحي بشكل خاص؛ لأن الشخصیة تلعب دوراً مهما في تطویر الأحداث داخل النص المسرحي، وكثیراً ما يعتمد المؤلف على أبعاد ومواصفات الشخصية القصصية في توصيل ما يرمي إليه من أفكار لتكون بمثابة مدلولٍ مادي على الكثير من الأفكار والمضامين الإنسانية. يهدف هذا البحث الذي يعتمد علی المنهج الوصفي_ التحلیلي إلى دراسة الشخصیة في مسرحیة "أنا أمك یا شاكر" لیوسف العاني، حيث سجلت هذه المسرحیة أول تأثیر للأدب الاشتراكي في المسرح العراقي لتناص شخصیة أم شاكر مع شخصیة الأُم عند "مكسيم غوركي". وأهم النتائج التي توصل إلیها البحث ما یلي: إن العاني هو أول كاتب عراقي یختار المرأة بطلاً للمسرحیة، وهي أم شاكر الأم ذات الإرادة الحدیدیة والوعي السیاسي غیر العادي والإیمان الذي لا یتزعزع في حتمیة الثورة الوطنیة وضرورة انتصارها. وقد اختار العاني شخصیات المسرحیة من بین الناس العادیین كي یتواصل معها الجمهور بسرعة، إذ إنّ الحقیقة التي أراد العاني أن یوصلها للجمهور دفعته لاستخدام اللهجة الدارجة لإیصال خطابه المسرحي والفكري للأمیّین من المجتمع الذین لا یجیدون القراءة والكتابة. ویبدو أنّ العاني اهتم بالمونولوج ولم یلتفت إلی بعض أبعاد الشخصیات، حیث لا نجد تحولا في الشخصیات، إذ بقیت كما هي طیلة المسرحیة وظلّت رهینة الثورة الشعبیة والحدث المسرحي، فلم تكن غنیة في ذاتها، لكنها كانت غنیة بالأفكار التي تؤدیها.
فرزانه واعظی، عنایت الله فاتحی نژاد، سید بابک فرزانه،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
منذ أواخر القرن العشرین ظهر مصطلح التاریخانیة الجدیدة علی أساس آراء المفكر الأمریکي ستیفن غرینبلت وذلك يکون کتيار مضاد للتاریخانیة التقلیدیة. یری أتباع هذه النزعة أن النصوص الأدبیة تقبل التأویل شأنها شأن النصوص التاریخیة؛ أي إذا کان التاریخ باعتباره ضرباً من الروایة، فإن الروایات تعتبر نوعاً من النصوص التاریخیة ولذلك جاء الاعتقاد عندهم بنصیة التاریخ وتاریخیة النص وعلی ذلك لایوجد هناك حدّ بین التاریخ والأدب ومن خلال قراءة النصوص الأدبية بعناية، يستطيع القارئ الحصول على معلومات تاريخية قيمة في الطبقات السفلى من النص. باستخدام المنهج الوصفي-التحليلي قامت هذه المقالة بتحليل رواية «عبث الأقدار» من أجل اكتشاف ودراسة الجوانب المهمّة من التاريخ والخطابات السائدة في عصر المؤلف. وفقاً لنتائج البحث، قد عرض نجيب محفوظ الخطابات والتوترات الفكرية والمواجهات الاجتماعية للمجتمع في منتصف القرن العشرين من خلال إعادة خلق قصص تاريخية فرعونية في هذه الرواية، ويمكن القول بأنّ العمل هو النتاج المعاكس لخطابات مثل إنكار المصير، وتعزيز روح النضال ومعارضة الاستبداد، وانعكاس الأصوات القومية، والمواجهة بين الأفكار الاستعمارية والمناهضة للاستعمار.
دکتور دانا طالب پور، دکتور حسن گودرزی لمراسکی، دکتور مهدي شاهرخ،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
تعدّ القصة من الأساليب المتميزة التي وظفها القرآن الكريم للتعبير عن المواضیع التاريخية والتربوية السامية ولهذا السبب تؤدي دوراً هاما في إيصال الرسالة المحمدية إلى البشر. ومن أبرز السمات الفنية التي تتميز بها القصص القرآني مقارنة بالقصص الأدبية الحضور المتميز لعنصر المفاجأة، حيث يمنح القصة القدرة على لفت انتباه المتلقي ودفعه إلى متابعة القراءة والكشف عن المعاني الجليلة المكنون فيها. والمفاجأة حدث مباغت مفاجئ للفاعل الأساس داخل القصة أو المتلقي خارج النص، وتتجلى الأحداث المفاجئة في كسر نمطية سير الأحداث. هناك طرائق فنية لتحقيق عنصر المفاجأة للقارئ لتحريكه نحو الأحداث وتشويقه. ولذلك أنماط مختلفة منها بما يشمل مفاجأة المتلقي والفاعل الرئيس في القصة و انكشاف سرّ المفاجآت للمتلقي وخفائه على فاعلي القصة . نظراً لأهمية هذه العناصر والأنماط في تسليط الضوء على الإعجاز القرآني معنى ومبنى وكثرة المشاهد المفاجئة في هذا الكتاب العظيم، تنوي هذه الورقة البحثية عبر توظيف المنهج الوصفي- التحليلي والاستعانة بكتب التفسير المعتمدة، الوصول إلى رصد تجليات هذا العنصر ودوره في إبانة جمالية المعاني المتميزة الموجودة في مشاهد مختارة من قصص سور يوسف والقصص والكهف فضلاً عن أنماطه المختلفة ودورها في كسر رتابة النص وإثارة انتباه المتلقي وكسر توقعه. تشير النتائج إلى أن هذا العنصر يلعب دوراً فعالاً في استيقاف نظر المتلقي وتحريضه على متابعة الأحداث القصصية ومشاركته الفعالة في تكملة أجزاء القصة بما يستتبع من تشويقه. توظيف هذا العنصر الفريد في نوعه يزيل الستار عن القدرة التعبيرية المعجزة عند الحق. المفاجأة في القرآن الكريم جاءت على عدة صور منها: مفاجأة المتلقي والفاعل الرئيس في القصة وانكشاف سرّ المفاجآت للمتلقي وخفائه عن فاعلي القصة. وتوظيف هذه الأنماط يضفي حركية وحيوية على النص القرآني ويكسر الرتابة التي یمکن أن تسيطر عليه. فالصورة الفنية الموجودة في مفاجأة القصص القرآني تساعد على استحواذها على قلب المتلقي وتحريضه على متابعة الأحداث مما يسهم في دفعها إلى منحى جديد.
زینه عرفت پور،
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
الملخّص
سحر خلیفة الروائیة المعاصرة الفلسطینیة تعدّ إحدی الروائیات المتميزات على الصعيدين العربي والعالمي؛ حيث لاقت رواياتها شهرة واسعة في العالم بأسره بسبب التزامها بالواقع الفلسطيني وخاصة المقاومة والقضايا الاجتماعية وقضایا المرأة، وأیضاً توظیفها بناءاً لغویاً أخاذاً یحرّك مشاعر القارئ ویجعله مشدوداً بأحداث الرواِیة. وفي روایة الصبار (المنشورة بعد نکبة عام ۱۹۶۷م) التي نحن بصدد دراستها، عاجلت فیها سحر خلیفة القضایا التي واجهها المجتمع الفلسطینی بعد هذه النکبة، تقوم الروائیة بتوظیف بناء لغوي تختلف غالباً مستویاته في أشکال سردها اختلافاً یجدر بنا أن ندرسه اعتماداً علی المنهج الوصفي- التحلیلي، علی ضوء تصنیف الأدیب والناقد الجزائري عبد الملک مرتاض. ومن النتائج التي توصّلنا إلیها، هي: إنّ سحر خلیفة وظّفت جمیع الأشکال السردیة التي یذکرها عبد الملک مرتاض في کتاب نظریة الروایة؛ أي: النسیج السردي، الحوار، والمناجاة، کما وظّفت جمیع الضمائر السردیة (ضمیر الغائب، ضمیر المخاطب وضمیر المتکلم) في روایتها، وضمیر الغائب هو الأکثر استعمالاً في سردها للأحداث. کما تعتمد سحر خلیفة غالباً في سردها القائم علی ضمیر الغیاب، علی لغة فصیحة متوسطة المستوی، وعندما ترید أن تسلّط الأضواء علی أجواء الحوار الذي یجري بین الطرفین داخل السرد، هي تتأرجح بین توظیف اللهجة الدارجة واللغة الفصیحة البسیطة، وعندما تترك المجال للشخصیات أن یتحاوروا مع بعض، نجد أنّ الشخصيات الغیر مثقفة تستخدم أکثر الأحیان لغة سوقیة عامیة ملحونة، والشخصيات المثقّفة تستخدم لغة فصيحة مبسّطة.
طاهرة حیدري،
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
الملخّص
تختلف الروایة البولیسیة عن غیرها من الروایات بأنّها تلعب دوراً کبیراً في تحفیز القاريء فإنّ الأدب العربي بأکمله یکاد یخلو من هذا النوع، أی الروایة البولیسیة التي مجالها الجریمة والتحقیق والبحث عن الحل في النهایة. فالعثور علیها أمر صعب وإن وجدنا هذا النوع، فإنّنا نجده محاولة لاترتقي الی المستوی المطلوب في الروایة البولیسیة. لعلّ الدافع للقیام بهذه الدراسة في مجال الروایة البولیسیة بعنوان «بنیة التشکیل والدلالة في روایة «ملك الهند»البولیسیة»، هو شغفنا بخوض هذه التجربة واختیار نموذج روائي لبناني بولیسي؛ لأنها تعتبر من الروایات البولیسیة للروائي جبور الدویهي. وفي هذا الاتجاه اخترنا منهجاً نستعین به في التنظیر والتطبیق وهو المنهج الوصفي- التحليلي في التعامل مع المتن الروائي بالوصف تارة واستقراء الأحداث والحقائق تارة أخری. وفي الأخیر یمکن القول: إنّ هذه الروایة دلیل علی أن المحکی البولیسي اللبناني، مازال في بدایته ولیس هناك تراکم کبیر لمثل هذه النصوص الروائیة، وإنّ هذه الروایات التي نعثر علیها في الأدب العربي واللبناني ما هي الّا محاولة من طرف الروائي للارتقاء بهذا الشکل.
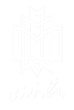
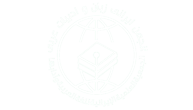
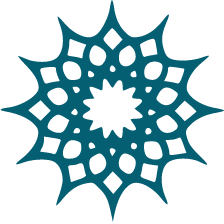

.png)
