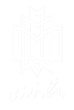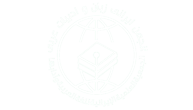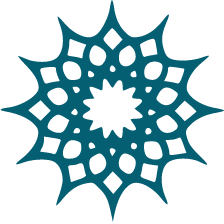

.png)
ابحث في مقالات المجلة
صادق هاشمی امجد، مهدی خرمی سرحوضکی، حسن مجیدی، سید مهدی نوری کیذقانی،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
اشتهر غریماس بإحدی البرامج السرديّة الهامّة أي النموذج العاملي الذي یُعتبر نموذج لتحلیل الحکي ویتعلّق بالنصوص الحکائية ویستهدف تجسید المسار لدی الشخصیات وتسجیل الأعمال والسلوکیات. یُقصد بالعامل کل ما له تأثير في إغناء الأحداث وازدهارها سواء أکان شخصيّة حیّة أو جماداً أو حیواناً أو فکرةً أو شيئاً له قوّة فعّاله ومؤثرة ضمن عالم النص السردي. یعتمد النموذج العاملي إلی ستة عوامل وهي: الذات، الموضوع، المرسِل، المرسَل إليه، المساعد، والمعارض. تأتي هذه العوامل في ثلاث روابط متمثّلة في الرَّغبة والتّواصل والصّراع. لقد سلّطنا الضوء في هذه الدراسة علی إحدی النصوص السرديّة أي المقامة السمرقندیّة للحريري وفق المنهج الوصفی-التحليلي بهدف معرفة عوامل إثراء النص وازدیاد تأثیره فی المتلقّي. والغاية من هذه الدراسة هو لزوم العودة إلى التراث وماجمّعه من نقاط مثيرة وما اشتمل عليه من براعةٍ فائقةٍ تتطلّب دراستها وإحياء اعتبارها الثّقافي والتاريخي. ومن أهمّ ما توصّلنا إلیه من نتائج أنَّ النموذج العاملي في التحليل السردي للمقامة السمرقندیّة کان قابلاً للتطبیق من خلال العلاقات المزدوجة بين العوامل کما توجد بعض العوامل المشترکة بين الترسيمات العاملية لهذه المقامة. کما أنّ تطبيق النموذج العاملي علی المقامة المذکورة قد ساهم في استخلاص المعنی من البنية السردية. وأدّت العوامل أکثر من دور في علاقاتها، فقد تکون حيناً ذاتاً أو مرسلاً وحيناً مرسلاً إليه، حسب تطوّر الحالات والتحوّلات في المقامة.
حيدر محلاتي، مروة الرکابي،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
فهد محمود الأسدي (۱۹۳۹-۲۰۱۳م) کاتب وقاص عراقي أبدع روايات ومجموعات قصصية تناولت المنحی الواقعي من الحياة الاجتماعية في العراق وخاصة حياة الناس في الأرياف. وقد أتقن الروائي حبك قصصه بأسلوب فني آسر يجذب المخاطب من خلال بنية قصصية متماسکة وعبارات ذات صور بلاغية تتناغم بتشبيهاتها ومجازاتها واستعاراتها الموحية. وهذه الدراسة تهدف إلى إبراز جمالية الصورة الفنية في هذه الروايات وإظهار ابداعات الروائي البيانية المتمثلة في روعة التشبيهات وبلاغة الاستعارات المستخدمة في النص القصصي. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي في محاولة لاستکشاف الإطار العام للصورة الفنية في مجموعات الأسدي القصصية، والإحاطة بالمميزات السردية التي اتضحت من خلال استعمال الروائي أغراضاً بلاغيةً موحية کالتشبيه والاستعارة والکناية لتضفي جماليةً مضاعفة وتقبّلاً ملموساً من قبل المتلقي. ورکّز هذا البحث في تحليله علی أعمال الأسدي الخمسة، وهي: رواية «الصليب؛ حلب بن غريبة» ورواية «دارة الإحسان» والمجموعة القصصية «عدن مضاع»، والمجموعة القصصية «طيور السماء»، والمجموعة القصصية «معمرة علي». وهذه الإبداعات السردية جميعها تصوّر الواقع الاجتماعي المرير الذي کان يعيشه الإنسان الجنوبي في العراق. ففي الرواية الأولی جسّد الروائي مظاهر الظلم والمعاناة التي کان يفرضها نظام الإقطاع علی الفلاحين والطبقات الضعيفة الکادحة، فراح يدعو من خلال دعوة غير مباشرة عن طريق هذه الرواية إلی نبذ جميع أنواع القهر والاستبداد والاضطهاد. أمّا الرواية الثانية فهي تمثّل العادات الاجتماعية السائدة في جنوب العراق بکل ما تحمل من معتقدات وخرافات وتقاليد عرفية لا يقبلها العقل السليم. وتعد هذه الرواية صورة حقيقية لتناقضات المجتمع الريفي وصراعه المستمر بين القديم والحديث. وتأتي المجموعة القصصية الثالثة لتبيّن بصريح العبارة التمايزَ الطبقي بين شرائح المجتمع الواحد، ومدی خطورته علی حياة الناس وتداعياته الکارثية التي تفضي إلی شرذمة الناس وتشتتهم. أمّا المجموعة الرابعة فقد تناولت قضايا الإنسان وهمومه الاجتماعية، وبينما جاءت المجموعة الخامسة لتنقد فقدان الوعي والجهل المستشري بين طبقات المجتمع المتخلف. ومن أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة: إنَّ الأديب الأسدي تعامل مع نماذجه القصصية بعفوية فنية خالصة معبّراً عنها ببيان سهل ممتنع ضمن دائرة التأويل واستکشاف بواطن الأمور من خلال تحليل ظواهرها الجلية. ولم يقحم الکاتب نفسه في مبالغات مفرغة وتهويلات لفظية طنانة تُخرج النص من جريانه الانسيابي وطاقاته المحتشدة، بل کان مُسايراً ومتناغماً مع لغة الخطاب وبناء السرد الفني.
صلاح الدین عبدی، اکرم ذوالفقاری،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ التفکيکية من الاتجاهات النقدية لما بعد الحداثة وزعیمها جاك دریدا الفرنسي، الجزائري المولد، وهي لیست منهجاً ونظرية عن الأدب لکنّها استراتيجية في القراءة وذهبت إلی لانهائية القراءات في ظل غیبة مرکزية النص ومقصدية المؤلف لتستبدلها بمقصدية جديدة وهي القارﺉ. هذه الاستراتيجية الجديدة التي قام بها دریدا مثل ثورة کوبرنیکوس في القرن السادس عشر في علم الفلك والنجوم. واعتقدت بأنّ اللغة بالنسبة إلیها مراوغة وغامضة وشيء غیر ثابت ولایمکن الاعتماد علیها ويخلقها القارﺉ عن طریق القراءة. وأهم المصطلحات في هذه الاستراتجية هي الکتابة، والاختلاف والإرجاء، والانتشار والتشتت، والأثر. يهدف هذا البحث إلى تحليل إحدى قصص زکریا تامر الکاتب السوري القصيرة المسماة "یا ایّها الکرز المنسي" من مجموعة "دمشق الحرائق" وإلی إثراء قرائتنا للنصوص الأدبية ومساعدتنا علی رؤية الأفکار المهمة والعميقة والتعرف على الاستراتيجية التفکيکية في النص وشرح ووصف أهم مصطلحات جاك دريدا وتطبيقها على نص عربي من المنظور التفکيکي وتقديم نموذج لتحليل النصوص بهذه الإستراتيجية الجديدة ورفض رؤية الذين یرونها غیر مناسبة في مجال الأدب واللغة. ومنهج البحث هو الوصفي -التحليلي. أمّا بالنسبة إلى ضرورة البحث وأهمیتها فهي فتح بوابة جديدة أمام عالم المعاني الواسع الموجود في النص، ولكن لم يتم عرض ذلك بسبب حصره في إطار بنية الجملة. وأهم النتائج التي وصلت إلیها المقالة هو اختلاف الدوال وتأجيل المعني بسبب تشتتها في النص وبعثرتها في کل زوایا النص والاستفاده من خارج النص. والثنائية الضدية أكثر ترداداً في القصة البراءة والانحطاط وإن ّالإيديولوجية التي تريد إلقائها هذه القصة القصيرة ضمن استراتيجية التفکيك من حیث قرائتنا هي الرفض والخروج من الأسر.
عاطفه بازیار، شهریار همتی، علی سلیمی، تورج زینی وند،
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۱ - ( ۵-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ المدينة الفاسدة أو "الديستوبيا" إحدى المضامين الّتي نشهدها في الآثار الأدبية. إنّ هذا الاتجاه يقع في النقطة المضادة للمدينة الفاضلة الّتي كان يأمل بها الشعراء والكتّاب منذ الزمان القدیم. يتطرق الأديب في الأدب المرتبط بالديستوبيا أو المدينة الفاسدة-بصورة مركزة- إلى بيان التأثيرات المخربة للمظاهر السياسية، والاجتماعية والصناعية. في الواقع، يعدّ هذا الأدب، مرآة تعكس القسم المظلم من المجتمع الّذي يعاني من البؤس والشقاء. وبما أنّ الرواية تنبعث من قلب المجتمع والحوادث الطارئة عليه؛ فإنّ هذا العنصر له انعكاس أوسع مقارنة مع العناصر الأدبية الأخرى في الرواية. وتحوّل إلى موتيف مكرر في هذه الرواية. إنّ "أحمد سعداوي"؛ الروائي العراقي المعاصر رسم لنا لوحة واضحة المعالم حول الحياة في بغداد وذلك من خلال روايته الشهيرة "فرانكشتاين في بغداد" وقد نظر فيها بنظرة مفرطة في التشاؤم بالنسبة إلى واقع حياة الإنسان في العصر الحديث. وقد صوّر لنا الكاتب في هذه الرواية، التأثيرات الرهيبة للأطر السياسية والاجتماعية على مستقبل حياة البشر وخاصة الشعب العراقي. يظهر لنا من خلال نتائج البحث بأنّ احتلال العراق على يد أمريكا والحوادث المريرة والعصيبة الّتي تلت ذلك، تسبب في ظهور وطن يملأه الفوضى والدمار. إنّ الرواية صورة مفزعة لظروف هذا المجتمع البائس ومظاهر المدينة الفاسدة تكشف عن نفسها -وبصورة رهيبة- في مواضع متعددة من الرواية. هذا البحث وفقاً للمنهج الوصفي-التحلیلي یقوم بدراسة ظواهر الدیستوبیا مثل الضلال والانحطاط الأخلاقي، الاستغلال من ناحية المجرمين، الحرمان من نعمة الأمن، الفوضى، العنف، وزوال مقومات الحياة السلمية والهجرة القسرية. صورة مفزعة لمجتمع تحوّل إلى جسد مفكك جراء الأحداث المريرة الّتي عانى منها إثر جبر الزمان. إنّ هذه الرواية تحمل معها كافة مكونات العمل الأدبي الذي يندرج ضمن الواقعية السوداء.
أستاذة کبری روشنفکر، نضال جاتول، هادی نظری منظم، مها هلال محمد،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
يعرف التناص بأنه الصوت المتعدد ذلك لأن كل نص هو في كنهه لوحة فسيفسائية مكونة من الاقتباسات عن نصوص أخرى. ومن هذا المنطلق يكون النص محض إعادة إنتاج لخبرات تراكمية سابقة، جمعت والتحمت في البناء النصي الجديد الذي نهض في هيكليته على أساس من نصوص سابقة متباينة ومتعددة ومتنوعة المشارب. ومن هنا يكون كل نص تناصا بصورة مطلقة، ذلك أن النص يبرز في عالم يغص بالنصوص (نصوص قبلية، ونصوص محيطة به، وأخرى حاضرة فيه)، واستراتيجيته المحورية هي الهدم والتفكيك بغرض إعادة البناء. یهدف هذا البحث دراسة تجليات التناص في الخطاب السردي لقصص مختاره عن القاص العراقی علي السباعي حتی یستنتج بان أبرز أنماط التناص التي يمكننا تمييزها في خطاب السباعي السردي في المجموعات القصصية المختارة (عينة البحث) نمطان رئيسان؛ الأول تناص ذاتي حصل مع نصوص الكاتب عينه، والآخر خارجي تفاعل فيه خطاب الكاتب السردي مع نصوص خارج حدود إبداعه الشخصي.
منیر زیبائي،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ العنوان هو العتبة الأولى للدخول على عالم النص أو فضائه الرئيس، ومن الناحية الأخرى، إنّ دلالة العنوان تعد من أهم المباحث اللغوية والدلالية التي تتركز على نقد العنوان، سواء في مجال الشعر أو الرواية، نقداً دلالياً؛ بحيث يؤدي هذا الأمر إلى الشفافية في المعنى والمفهوم لدى القارئ أو المتلقي. ويعد نجم والي أيضاً من الرواة العراقیین المعاصرين، والذي له يد قصوى في كشف الحقيقة الاجتماعية عبر استخدام عناوين روائية دقيقة لرواياته، بحيث إن لكل عنوان رواية دلالة على الحقائق الاجتماعية والثقافية أو السياسية. وفي هذه الدراسة، ومن خلال الاعتماد على المنهج الوصفي- التحليلي نهدف إلى تسلیط الضوء علی ماهية دلالة العنوان ومستوياتها المتجلية في المستوى المعجمي، والمستوى الدلالي، والمستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، وتطبيق هذه المستويات على عناوين نجم والي الروائية، واستقصاء دلالاتها ومؤشراتها المعنوية. ومن النتائج التي توصل إليها المقال هي أن نجم والي لم يختر عناوين رواياته دون وعي، بل قصد من خلال اختيارها مقاصد خاصة، ومن جهة أخرى، إنها ترشدنا إلى قضايا ومفاهيم اجتماعية في العراق.
محمد نادری، اکرم روشنفکر، فرهاد رجبی،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ الرواية باعتبارها نمطاً سردياً يعتمد على تقنيات متنوعة في الكتابة، تتمتع بكامل القدرة على التحليل وذلك على ضوء النظريات التي تحدّثت عن عناصرها وكيفية توظيفها. من هذا المنطلق، عمل جينيت على إكمال إجراءات النقاد البارزين في بيان وظائف الزمن الروائي وقدّم نموذجاً بنيوياً متميزاً يمكن أن يكون -إلى جانب عنصر المكان- أرضية خصبة للدراسة والبحث. تتطرق هذه الدراسة عن طريق المنهج النقدي اللغوي الجينيتي إلى دراسة بنية الزمن في رواية "اسكندرونه" لفضل مخدر. إنّ الروائي اجتهد من خلال اعتماده على أسلوب الحوار بين الراوي-البطل والشخصيات الفرعية، أن ينظّم النصّ الروائي بناء على معدّل السرعة المعيارية التي نادى بها جيرار جينيت. ومن خلال توسّله إلى الماضي، يقيم نوعاً من التوازن المطلوب بين ذكره للأحداث والأبطال الثانويين في الزمن الضائع. مع ذلك، لم يختصر الكاتب على اعتماد بنية جينيت الزمنية؛ وقد وظّف أحياناً أسلوبي الحذف والتلخيص؛ لكي يمنح روايته سرعة أكبر أو يعتمد على أنواع الوقفات للحدّ من سرعة الزمن في الرواية ويقودها إلى السرعة السلبية. وقد تبيّن لنا من خلال نتائج البحث بأنّ "فضل مخدر" اتخذ أقصى درجات الزمنية في روايته "اسكندرونه" على ضوء نموذج جينيت. وإنّ الرواية تتمتع بنوع من النظم والترتيب الزمني الذي قام به الراوي-البطل؛ ليس هذا فحسب، بل يعاني الراوي نفسه أيضاً بالتشويش الزمني الّذي ينتهي به المطاف إلى الزمن الماضي. مع ذلك، فإنّ قمة إبداع الرواية تتمثّل في النظرة المتميزة بالنسبة إلى المستقبل؛ وهي نظرة أودعها الروائي في النهاية المفتوحة لرواية المقاومة. ويبدو أنّ عقربة الزمن في "اسكندرونه" تتراوح -على أساس نموذج جينيت- ما بين السرعة المعيارية والسرعة السلبية.
شاكر العامري، علي شهرياري،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
تعد الشخصیة من العناصر الرئیسة في الروایة بشكل عام وفي النص المسرحي بشكل خاص؛ لأن الشخصیة تلعب دوراً مهما في تطویر الأحداث داخل النص المسرحي، وكثیراً ما يعتمد المؤلف على أبعاد ومواصفات الشخصية القصصية في توصيل ما يرمي إليه من أفكار لتكون بمثابة مدلولٍ مادي على الكثير من الأفكار والمضامين الإنسانية. يهدف هذا البحث الذي يعتمد علی المنهج الوصفي_ التحلیلي إلى دراسة الشخصیة في مسرحیة "أنا أمك یا شاكر" لیوسف العاني، حيث سجلت هذه المسرحیة أول تأثیر للأدب الاشتراكي في المسرح العراقي لتناص شخصیة أم شاكر مع شخصیة الأُم عند "مكسيم غوركي". وأهم النتائج التي توصل إلیها البحث ما یلي: إن العاني هو أول كاتب عراقي یختار المرأة بطلاً للمسرحیة، وهي أم شاكر الأم ذات الإرادة الحدیدیة والوعي السیاسي غیر العادي والإیمان الذي لا یتزعزع في حتمیة الثورة الوطنیة وضرورة انتصارها. وقد اختار العاني شخصیات المسرحیة من بین الناس العادیین كي یتواصل معها الجمهور بسرعة، إذ إنّ الحقیقة التي أراد العاني أن یوصلها للجمهور دفعته لاستخدام اللهجة الدارجة لإیصال خطابه المسرحي والفكري للأمیّین من المجتمع الذین لا یجیدون القراءة والكتابة. ویبدو أنّ العاني اهتم بالمونولوج ولم یلتفت إلی بعض أبعاد الشخصیات، حیث لا نجد تحولا في الشخصیات، إذ بقیت كما هي طیلة المسرحیة وظلّت رهینة الثورة الشعبیة والحدث المسرحي، فلم تكن غنیة في ذاتها، لكنها كانت غنیة بالأفكار التي تؤدیها.
فرزانه واعظی، عنایت الله فاتحی نژاد، سید بابک فرزانه،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
منذ أواخر القرن العشرین ظهر مصطلح التاریخانیة الجدیدة علی أساس آراء المفكر الأمریکي ستیفن غرینبلت وذلك يکون کتيار مضاد للتاریخانیة التقلیدیة. یری أتباع هذه النزعة أن النصوص الأدبیة تقبل التأویل شأنها شأن النصوص التاریخیة؛ أي إذا کان التاریخ باعتباره ضرباً من الروایة، فإن الروایات تعتبر نوعاً من النصوص التاریخیة ولذلك جاء الاعتقاد عندهم بنصیة التاریخ وتاریخیة النص وعلی ذلك لایوجد هناك حدّ بین التاریخ والأدب ومن خلال قراءة النصوص الأدبية بعناية، يستطيع القارئ الحصول على معلومات تاريخية قيمة في الطبقات السفلى من النص. باستخدام المنهج الوصفي-التحليلي قامت هذه المقالة بتحليل رواية «عبث الأقدار» من أجل اكتشاف ودراسة الجوانب المهمّة من التاريخ والخطابات السائدة في عصر المؤلف. وفقاً لنتائج البحث، قد عرض نجيب محفوظ الخطابات والتوترات الفكرية والمواجهات الاجتماعية للمجتمع في منتصف القرن العشرين من خلال إعادة خلق قصص تاريخية فرعونية في هذه الرواية، ويمكن القول بأنّ العمل هو النتاج المعاكس لخطابات مثل إنكار المصير، وتعزيز روح النضال ومعارضة الاستبداد، وانعكاس الأصوات القومية، والمواجهة بين الأفكار الاستعمارية والمناهضة للاستعمار.
دکتور دانا طالب پور، دکتور حسن گودرزی لمراسکی، دکتور مهدي شاهرخ،
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۲ - ( ۶-۱۴۴۵ )
الملخّص
تعدّ القصة من الأساليب المتميزة التي وظفها القرآن الكريم للتعبير عن المواضیع التاريخية والتربوية السامية ولهذا السبب تؤدي دوراً هاما في إيصال الرسالة المحمدية إلى البشر. ومن أبرز السمات الفنية التي تتميز بها القصص القرآني مقارنة بالقصص الأدبية الحضور المتميز لعنصر المفاجأة، حيث يمنح القصة القدرة على لفت انتباه المتلقي ودفعه إلى متابعة القراءة والكشف عن المعاني الجليلة المكنون فيها. والمفاجأة حدث مباغت مفاجئ للفاعل الأساس داخل القصة أو المتلقي خارج النص، وتتجلى الأحداث المفاجئة في كسر نمطية سير الأحداث. هناك طرائق فنية لتحقيق عنصر المفاجأة للقارئ لتحريكه نحو الأحداث وتشويقه. ولذلك أنماط مختلفة منها بما يشمل مفاجأة المتلقي والفاعل الرئيس في القصة و انكشاف سرّ المفاجآت للمتلقي وخفائه على فاعلي القصة . نظراً لأهمية هذه العناصر والأنماط في تسليط الضوء على الإعجاز القرآني معنى ومبنى وكثرة المشاهد المفاجئة في هذا الكتاب العظيم، تنوي هذه الورقة البحثية عبر توظيف المنهج الوصفي- التحليلي والاستعانة بكتب التفسير المعتمدة، الوصول إلى رصد تجليات هذا العنصر ودوره في إبانة جمالية المعاني المتميزة الموجودة في مشاهد مختارة من قصص سور يوسف والقصص والكهف فضلاً عن أنماطه المختلفة ودورها في كسر رتابة النص وإثارة انتباه المتلقي وكسر توقعه. تشير النتائج إلى أن هذا العنصر يلعب دوراً فعالاً في استيقاف نظر المتلقي وتحريضه على متابعة الأحداث القصصية ومشاركته الفعالة في تكملة أجزاء القصة بما يستتبع من تشويقه. توظيف هذا العنصر الفريد في نوعه يزيل الستار عن القدرة التعبيرية المعجزة عند الحق. المفاجأة في القرآن الكريم جاءت على عدة صور منها: مفاجأة المتلقي والفاعل الرئيس في القصة وانكشاف سرّ المفاجآت للمتلقي وخفائه عن فاعلي القصة. وتوظيف هذه الأنماط يضفي حركية وحيوية على النص القرآني ويكسر الرتابة التي یمکن أن تسيطر عليه. فالصورة الفنية الموجودة في مفاجأة القصص القرآني تساعد على استحواذها على قلب المتلقي وتحريضه على متابعة الأحداث مما يسهم في دفعها إلى منحى جديد.
طاهرة حیدري،
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
الملخّص
تختلف الروایة البولیسیة عن غیرها من الروایات بأنّها تلعب دوراً کبیراً في تحفیز القاريء فإنّ الأدب العربي بأکمله یکاد یخلو من هذا النوع، أی الروایة البولیسیة التي مجالها الجریمة والتحقیق والبحث عن الحل في النهایة. فالعثور علیها أمر صعب وإن وجدنا هذا النوع، فإنّنا نجده محاولة لاترتقي الی المستوی المطلوب في الروایة البولیسیة. لعلّ الدافع للقیام بهذه الدراسة في مجال الروایة البولیسیة بعنوان «بنیة التشکیل والدلالة في روایة «ملك الهند»البولیسیة»، هو شغفنا بخوض هذه التجربة واختیار نموذج روائي لبناني بولیسي؛ لأنها تعتبر من الروایات البولیسیة للروائي جبور الدویهي. وفي هذا الاتجاه اخترنا منهجاً نستعین به في التنظیر والتطبیق وهو المنهج الوصفي- التحليلي في التعامل مع المتن الروائي بالوصف تارة واستقراء الأحداث والحقائق تارة أخری. وفي الأخیر یمکن القول: إنّ هذه الروایة دلیل علی أن المحکی البولیسي اللبناني، مازال في بدایته ولیس هناك تراکم کبیر لمثل هذه النصوص الروائیة، وإنّ هذه الروایات التي نعثر علیها في الأدب العربي واللبناني ما هي الّا محاولة من طرف الروائي للارتقاء بهذا الشکل.
علي اكبر نورسيده، ریحانه امامی چهارطاق،
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
الملخّص
نشأ التحليل النقدي للخطاب من علم اللغة النقدي وأفكار علماء مثل فوكو وهابرماس وألتوسير. تظهر المحاور الرئیسة في دراسة هذا النوع من النصوص الأدبية في معرفة مفاهيم کالرؤية النقدية والقوة والإیدئولوجیا والاستعارة. تظهر الرؤية النقدية للخطاب في كيفية توظيف مستخدمي اللغة للاستعارة لإظهار إيديولوجيا المجموعات القوية بين الناس ومتلقّي النص. بعد ظهور علماء مثل ويداك، وفاندايك، وفيركلاف في التحليل النقدي للخطاب ظهرت مناهج مختلفة مثل منهج المجال الاجتماعي لفاندايك، ومنهج الخطاب التاريخي لويداك، ومنهج فيركلاف الذي يعتبر الخطاب عملاً اجتماعياً ويحلله. یری نورمان فيركلاف، بأنّ تحليل الخطاب هو تحليل كل من الأبعاد الثلاثة (الفعل الاجتماعي، الممارسة الخطابية، النص)، لأن فرضيته مبنية على حقيقة وهي أنّ هناك صلة ذات معنى بين المعاني المحددة للنصوص وطرق ارتباط النصوص ببعضها وتفسيرها، وطبيعة الفعل الاجتماعي، ويتم فحصها على ثلاثة مستويات: الوصف والتفسير والشرح. تتناول الكاتبة اللبنانية المعاصرة هدى بركات حياة المهاجرين والمشرّدين واللاجئين الذين يضطرون إلى ترك منازلهم لسوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويعيشون حياة صعبة في فرنسا. تمت في هذا البحث، من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي محاولة التحقق من تطبيق مستويين من التفسير و الشرح في رواية بريد الليل على ضوء منهج الخطاب النقدي عند نورمان فيركلاف. تشير نتائج البحث إلى أن استخدام الإمكانيات المعجمية على مستوى المعنى جعل النص متماسكاً في هذه الرواية، وتمكنت الراوية باستخدامها تغيير المنظور والمفاهيم العقلية في فكرها حول نقل مفاهيم کالوحدة والانفراد والخوف والحرب والذعر والتوقع للمتلقّين. وقد حاولت التعريف بشرائح المجتمع المختلفة التي تأثرت بظاهرة الهجرة القسرية وبيان أسباب الهجرة ومغادرة الوطن عبر تصویرها في أسماء خاصة.
علي پوردلفي زاده، حسين كياني،
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ السرعة أصبحت تضع بصمتها على جميع جوانب الحياة البشرية بما فيها الجانب الأدبي، الذي يعدّ الصورة الكاملة للمجتمع الإنساني. ظهور القصة القصيرة جدّاً لم يكن محض ظهور مباغت، وإنما كان بدافع متطلبات الحياة الحديثة التي تريد إنجاز الأمور بسرعة فائقة، فظهر هذا النوع القصصي القصير جداً يحمل الأفكار المكثّفة والواسعة على أسس جوهرية لا غنى عنها. يعدّ التكثيف أحد هذه الأسس لبناء قصص حديثة وقصيرة ومكثفة كما يتضح من عنوانها، فالقاص ولكي يتوصل إلى التكثيف لا بدّ وأن يوظّف بعض الآليات في قصصه؛ ليتمكن من كتابة نص قصصي مميز يجذب القارئ إليه ويشدّه لقراءته. إنّ الاعتماد على المنهج البنيوي في دراسة عيّنات قصصية قصيرة جداً أدّى إلى أنّ عدم اقتصار التكثيف على التقليل من عدد الكلمات فحسب، وإنما شمل الفكرة والشخصية والزمكانية، فضلًا عن التكثيف اللغوي والصوري والحدثي، فتمكن القاص محمد محقق باستخدام آليات المفارقة وفعلية الجمل أن يحقق نصوصاً قصصية مكثفة، لكن الطرق التي اعتمدها القاص لم تختصر على هذه فحسب، بل إن التناص والرمزية أيضاً يسجلان حضورهما كآليتين تمكن القاص من خلالهما كتابة نصوص قصصية مكثفة، ولكن بنسبة أقلّ عن المفارقة وفعلية الجمل، وهذا ما يجعل الطرق المذكورة أكثر استخداماً في المجموعة القصصية موضع الدراسة، وذلك بإجادة وإتقان كبيرين.
فاطمة بوعذار، حسین مهتدي، ناصر زارع، سید حیدر فرع شیرازی،
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنَّ تقنية التبئير تقع ضمن مقولة الصيغة التي تتمّ فيها معرفة وجهة النظر في الحكاية التي يسردها السارد، بعبارة أخری إنّ هذه التقنية تتمحور حول الذي یری وليس الذي يحکي. لذلك كانت تقنية التبئير وفقاً لرؤية جيرار جينت تتراوح بين ثلاثة مستويات، وهي: الحكاية ذات التبئير الصفر، الحكاية ذات التبئير الداخلي، الحكاية ذات التبئير الخارجي. تأتي تقنية التبئير في رواية "ممرات" لتعرض هويتين متعارضتين في الظاهر من خلال شخصيتين راويتين؛ كلاهما تنتميان لهوية خاصة سبّبها الاحتلال الصهيوني. لذلك جاءت شخصية نجوى الساردة لتعبّر عن مجتمعها الفلسطيني - المسلم والذي يعيش في المخيمات، وشخصية دارين الساردة لتعبر عن المجتمع الفلسطيني - المسيحي في لبنان. تعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي – التحليلي بناءً علی نظرية جيرار جينيت في التبئير وتهدف إلى تحليل أسلوب الكاتبة في رواية "ممرات" التي تعكس الواقع في العالم العربي إبان الاحتلال الصهيوني. وقد تمکن هذا البحث من الوصول إلی أنَّ التبئير کان حاضراً بأنواعه الثلاثة ومعظمه کان خلال وجهة نظر الشخصيتين الأساسیتين في الرواية اللتين عبّرا عن موقفهما تجاه المقاومة الفلسطينية، لكن جاء التبئير الداخلي في معظم الرواية على لسان نجوی صاحبة المعرفة الکلية بالقضية الفلسطينية التي أرادت أن تقرب صديقتها المسيحية إلی ما يجري في فلسطين من مذابح ومجازر،وذلك عبر رسائل دارت بينهما.
گل افروز محبی، امیر حسین رسول نیا، روح الله صیادی نجاد،
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۳ - ( ۱۰-۱۴۴۵ )
الملخّص
يعد اكتشاف العلاقات التناصية والعمليات اللغوية التي تحكم مساحة النص دائماً أحد أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام بالنسبة لعلماء اللغة. في السبعينيات، قدم مايكل ريفاتر (۱۹۷۸)، وهو عالم لغوي وسيميائي فرنسي أمريكي، نظريته في القراءة السيميائية مع وجهة نظر مفادها أن النص الأدبي عبارة عن بنية معقدة ويمكن فحصها من زوايا مختلفة. إنّ القراءة السيميائية عند ريفاتر هي نظرية في القراءة النصية تقوم على أن النص الأدبي هو فعل تواصلي يحدث بين المؤلف والقارئ. باستخدام العلامات يغرس المؤلف معنى في النص ويفهم القارئ معنى النص من خلال تفسير هذه العلامات. يرى ريفاتر بأنّ النص الأدبي له بنية متعددة الطبقات. المستوى الأول من النص هو المستوى الظاهر أو المستوى الصفري الذي يفهمه القارئ في المقام الأول. المستوى الثاني للنص هو مستوى فك التشفير أو المستوى الأول، حيث يفهم القارئ المعنى الأعمق للنص من خلال فهم العلامات والعلاقات بينها. المستوى الثالث للنص هو مستوى الإنتاج أو المستوى الثاني، حيث ينتج القارئ معنى جديدا لنفسه من خلال التفاعل مع النص. تتكون هذه النظرية من المخالفات، عملية التراكم، الأنظمة الوصفية، الهیبوغرام والمصفوفة. أجري هذا البحث بأسلوب وصفي-تحليلي بهدف قراءة سيميائية لرواية «الشمس في يوم غائم» للكاتب السوري الشهير حنا مينا. تشير نتيجة هذا البحث إلى أن مصفوفة النص عبارة عن شبكة من العلاقات الدلالية بين مختلف الأشكال الناقصية التي تشكل البنية الدلالية للنص. نتيجة التركيز على البنية اللغوية في هذا العمل هي المصفوفة التي تم تحديدها في نص الرواية وهي «إسقاط النظام البرجوازي». هذه المصفوفة عبارة عن شبكة من العلاقات الدلالية بين الهیبوغرامات الثلاثة «الطبقة البرجوازية» و«الیقظة الاجتماعیة» و«الانتفاضة العامّة». في هذه المصفوفة، يتم تقديم الطبقة البرجوازية باعتبارها السبب الرئيسي لعدم المساواة والتمييز في المجتمع. تتمتع هذه الطبقة بالثروة والسلطة وتستخدم هذا المنصب لاستغلال الطبقات الدنيا في المجتمع. نتيجة هذا الاستغلال هي الصحوة الاجتماعية لدى الشعب، مما يجعل الناس يسعون إلى تغيير النظام القائم. يمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى إنهاء النظام الرأسمالي وإنشاء مجتمع أكثر عدالة. نظر لاعتماد هذا النقد السيميائي على التفسير الشخصي للقارئ، يمكن القول بأنّ هذه النظرية ذاتية إلى حد كبير.
زینب نیستانی، نعیمه پراندوجی، فاطمه عارفی فر،
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
الملخّص
الاهتمام بقضايا المرأة ومرکزيتها في الأعمال الأدبية من المسائل التي أثارت اهتمام العديد من الباحثين في مختلف المجالات الاجتماعية، والثقافية والأدبية خلال القرنين الأخيرين. يقوم النقد النسوي بدراسة الأثار الأدبية التي کتبت بيد المرأة أو حول المرأة. إلين شوالتر من المنظِّرات في هذا المجال اقرحت أربعة مناهج لدراسة النقد النسوي وهي المنهج البيولوژي، اللغوي، النفسي والثقافي. من بين المناهج التي اقترحتها إلين شوالتر يلعب المنهج الثقافي دوراً هاماً في دراسة انعکاس القضايا الاجتماعية، والسياسية والثقافية في الأدب والرواية. يهتم هذا المنهج بدراسة النظرة السائدة للمرأة في المجتمع و دور المجتمع في تشکيل عمل المرأة ونشاطها ومکانتها. نظراً لأهمية المنهج الثقافي لإلين شوالتر في دراسة الأدب القصصي والرواية، يقوم هذا المقال بدراسة رواية «اصل وفصل» لسحر خليفة على أساس هذا المنهج على ضوء المنهج الوصفي-التحليلي لکي يدرس کيفية انعکاس القضايا الإجتماعية في الرواية ويسعى أن يجيب عن هذا السؤال: ماهو تأثير المجتمع الفلسطيني في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين علی أفکار سحر خليفة واتجاهاتها؟ وکيف يتجلی هذا التأثير في الرواية ويمکن دراسته من خلال المنهج الثقافي لإلين شوالتر؟ نتائج البحث تشير إلی أنّ سحر خليفة تحدت المجتمع الأبوي الفلسطيني في النصف الأول من القرن العشرين والسنوات الأولی للاحتلال من خلال معالجة مقومات المنهج الثقافي لإلين شوالتر کالاهتمام بالحياة والاستقلال الاقتصادي، کراهية النسيان التاريخي للمرأة، اکتشاف الذات والتعبير عن الواقع حول المرأة، الزواج القسري والتقليدي للمرأة، قيود تعليم المرأة، تحقير المرأة وإهانتها و .... أدانت هيمنة الرجل علی المرأة. ولذلك فإن المجتمع التقليدي الفلسطيني آنذاك أثّر في کل أبعاد واتجاهات أفکار سحر خليفة. بحيث تعتبر خليفة سيطرة الرجل علی المرأة کسيطرة إسرائيل علی فلسطين وتدينها. وکما المرأة في فکر خليفة رمز للوطن والأرض.
مائده ظهري عرب، رجاء أبوعلي،
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
الملخّص
تمیّزت روایة مابعد الحداثة بجملة من الخصائص، ومن تلك الخصائص، یحاول البحث رصد صور التشظّي في روایة مابعد الحداثة، حیث إنّ بعض روائیو مابعد الحداثة اعتمدوا علی هذه التقنیة السردیة الجدیدة التي تعمل علی تهشیم الحبكة السردیة وكسر السرد الخطي المنظّم. وقد مثّلت الروایة المتشظّیة المؤثر الأكبر في أدب ما بعد الحداثة بوصفها رؤیة جدیدة تلائم متطلبات العصر لما لها من قدرة علی خلق قواعد جدیدة تختلف عن القواعد التقلیدیّة. ومن هذا المنطلق، یعدّ التشظّي إحدی سمات روایة ما بعد الحداثة وهو الانزیاح عن التقالید والابتعاد عن الانتظام والتماسك والتقنین في النصّ الروائي وهو الطریقة الأكثر وضوحاً لتوسیع آفاق الروایة الجدیدة. مثّلت روایة "ورّاق الحب" لخلیل صویلح نموذجاً جیداً لروایة ما بعد الحداثة لأنّها تضمّنت أشكالاً من التشظّي في السرد وتجلّت أهمیة بحثنا في أنّ روایة "خلیل صویلح" هي استكشاف قوي ومؤثر للتشظّي والتبعثر الموجود داخل المجتمع وهي تعلیق علی الحالة الإنسانیّة في عالم یتسم بالانقسام واللاانتظام. ورأینا من خلال دراستنا لهذه الروایة عبر المنهج الوصفي- التحلیلي أنّ من أبرز ملامح التشظّي في هذه الروایة هي التشظّي في الحبكة، البناء الزمكاني المتشظي، انعدام القصة، تحرّر الكاتب من كل القیود والكتابة المتشظّیة. كما توصلنا إلی أنّ التشظي یدلّ علی فكرة الفوضی والوجود المحطّم الذي تعیشه الشخصیّات، وبما أنّ كل شخصیّة ممزّقة بین ماضیها وحاضرها وبین رغباتها وواقعها وإن الإضطراب والتشویش في الزمان والمكان یدلّ علی عدم الیقین وعدم استقرار الذات.
فاطمه سلگی، کبری روشنفکر، فرامرز میرزایی،
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
الملخّص
إنّ الرواية كوسيلة فنية تشكل تمثيلاً سردياً يستحضر الواقع ويروي قصة المجتمعات والأفراد. وفي سياق الرواية العراقية الجديدة، تكمن أهمية هذا التمثيل السردي في تصوير الوجع العراقي وتجسيده بأسلوب يلامس الواقع والمشاعر الإنسانية، وتتجلّى اللغة كأداة رئيسة في تصوير الواقع العراقي، فمن هذا المنطلق تأتي خطورة المنهج الأسلوبي لاعتباره النصّ الأدبي عملاً لغوياً ذا وظائف مختلفة. شكلت الرواية العراقية جزءاً هاماً من السرد العربي المعاصر، وتحظى بمكانة مرموقة وبارزة في الساحة الأدبية العربية. كما شهدت السنوات الأخيرة ظهور روايات تناقش مشاكل يعانى منها المجتمع. وبناء على ذلك، تأتي هذه الدراسة محاولة بيان صورة الوجع العراقي انطلاقاً من الأسلوبية اللغوية على ضوء رواية "حلم وردي فاتح اللون" لميسلون هادي، كما يحاول إبراز مكامن التمیز الأسلوبي للكاتبة ولروایتها موضوع الدراسة. تتحدد مشكلة الدراسة في تحديد مميزات الرواية العراقية بعد عام ۲۰۰۳م، وذلك من خلال تحليل الأسلوبية اللغوية في رواية "حلم وردي فاتح اللون" للكاتبة ميسلون هادي، والتركيز بشكل خاص على الوجع العراقي في هذه الرواية. اعتمدت الدراسة علی المنهج الوصفي-التحليلي المعتمد علی التحليل الأسلوبي المتمثل في المستويات الترکیبیة والبلاغیة والدلالیة لمکانتها المهمة فی التحلیل الأسلوبی للسرد. أظهرت النتائج أنّ الروائية العراقية تمكنّت من إبراز قدرتها الفنية والإبداعية في التعبير عن تجاربها الشخصية والاجتماعية، وذلك من خلال استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات الأسلوبية. وبالتحليل اللغوي للرواية نجد أنّها تتميز بأسلوب لغوي فريد، حيث تسهم الأساليب التركيبية والبلاغية والدلالية في خلق تجسيد لغة الوجع والحزن والخوف مما يعكس واقعاً مأساوياً يعاني منه الشعب العراقي جراء الحروب والاحتلال والصراعات السياسية والاجتماعية.
مريم قاسم محمد النصراوي، احمدرضا حیدریان شهری، احمد مهدي الزبيدي،
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
الملخّص
يهدف البحث إلى الكشف عن التمثلات الاجتماعية للسلطة البطرياركية في الرواية العراقية المتمثلة (نحيب الرافدين) لعبد الرحمن مجيد الربيعي(۱۹۳۹) ومقارنتها بالرواية الفارسية لعباس معروفي (۱۹۵۷) (کان لفريدون ثلاثة أبناء). إنّ الدراسة غير معنية بالمستوى الجمالي في البنية السردية. وإنما معنية بالمنطقة الثقافية وتسرّباتها في النص السردي. وحين نقرأ التمثلات فهذا يعني سنركز على التمثل بوصفه تقمصّاً واعياً يقوم على التبني الخطابي الفاضح للظواهر المجتمعية والثقافية، وحين يحمل العنوان ثيمة السلطة البطرياركية فلأنها تعني تلك السلطة الأبوية التي شاعت في سبعينيات القرن الماضي في الدراسات النسوية والذي يعني هيمنة السلطة الذكورية على المجتمع في ظل عوامل مرجعية تراكمية. وتتركز أهمية الموضوع في الكشف عن مفهوم الأبوية المهيمنة بكل تجلياتها وممارساتها بوصفها سلطة (أب، وشيخ عشيرة، الحاکم، وسلطة الدولة وغيرها، والكشف عن العلاقة بين الرواية العراقية والإيرانية فيما يخص التوجه الروائي نحو فضح السلطة البطرياركية بكونها ظاهرة من الظواهر الثقافية السائدة في المجمتعين) بالمنهج الثقافي المقارن حسب المدرسة الأمريكية عن الأنساق المضمرة والظواهر الثقافية المتمثلة في النص الجمالي. وتشير النتائج المستخلصة إلى أن التمثل الاجتماعي للسلطة البطرياركية تظهر في عدة محاور منها الفضاء الزمكاني المشترك للنساء وبالتالي الأحداث الاجتماعية المشتركة التي تتشابه إلى حد كبير جداً في الروايتين كذلك المظاهر الماركسية والتي تتمثل بالاغتراب والفقر في الرواية. في رواية نحيب الرافدين يشير الراوي إلى المصريين في العراق وأيضاً ظاهرة الطبقية، بينما ركز معروفي على الفقر خارج الفضاء البلد وبتأثير مباشر من الفكر الماركسي السياسي، أمّا عن العلاقات العاطفية فركز الروائيان على مسألة الغريزة الحسية وبصراع سلطة اجتماعية متداخلة وكشف الربيعي ذلك بصراع اجتماعي و ديني في فضاء شرقي، ولكن معروفي أشار إلى السطة الاجتماعية أکثر في الفضاء الغربي.
عبدالباسط عرب یوسف آبادی، فاطمه بيري،
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
المجلد ۵، العدد ۴ - ( ۱۲-۱۴۴۵ )
الملخّص
جاءت الحداثة ومابعدها لتقدّم تحليلات مختلفة وتجارب جديدة في السرد، إذ قامت بتحطيم القواعد الفنية المألوفة للرواية وتشكيل صيغ جديدة للتحرّر من قيود الصوت الأحادي للسرد متجاوزة التنميط والنمذجة والأحادية في الأصوات. يتحقّق هذا الاتّجاه بكسر التماسك، واستبداله بمنطق التفكيك والتشتيت، وسيلان الحدود الفاصلة بين الضمائر، وانتقال الراوي من هيمنة صوت الأنا إلى هيمنة صوت الآخرين؛ وهذا ما سمّاه النقاد بتقنية الأصوات المتعددة. ولأهمية هذا الأسلوب، اعتمد الباحثون عليه کموضوع للدراسة، هذا بالإضافة لقلّة تطبيقه في العملية النقدية للنصوص السردية في نتاجات ربيع جابر (۱۹۷۲م)، الروائي اللبناني الذي نال الجائزة العالمية للرواية العربية. وقف ربيع جابر بالأسلبة الروائية عند حدود تعدد الأصوات في رواية «الاعترافات» (۲۰۰۷م)، حيث تؤدّي معظم شخوصها دوراً في رواية الوقائع وسرد مجرى الأحداث، فلا يبدو السارد سلطوياً بشخوص عالم السرد. وأهم ما توصّل إليه البحث هو أنّ تعدد الأصوات يظهر في هذه الرواية من خلال تقديم وجهات نظر مختلفة، وتنويع الشخصيات وخلفياتهم، واستكشاف قضايا اجتماعية وسياسية من وجوه نظر متعددة. يساهم هذا التنوع في إغناء الحبكة السردية وتقديم رؤى جديدة للواقع العربي. وتحتوي عملية عرض شخوص الرواية على أساليب كلامية متعددة ولكن ليس ربيع جابر هو الذي يدلي باعترافاته، فهو ليس الراوي في روايته، إنه المروي عليه والمروي له.
مجلة دراسات في السردانیة العربیة
التصمیم و البرمجة : یکتاوب افزار شرق
© 2025 | Studies in Arabic Narratology
Designed & Developed by : Yektaweb