یسرى شادمان،
المجلد ۱، العدد ۲ - ( ۱-۱۴۴۲ )
الملخّص
إن القصة العربیة الیوم هي نتیجة التطوّر الفکري العالمي، علی أنها إنما نشأت وترعرعت بتأثیر الفن القصصي في الغرب. فدخلت الروایة العربیة مع بدایة عقد الستینات من القرن العشرین، مرحلة جدیدة من مراحل تطوّرها. تهدف هذه الدراسة تحليل الخصائص السردیة للرواية العربیة المعاصرة من خلال المنهج الوصفي-التحلیلي الذي يصف الموضوع وصفاً موضوعياً من خلال البيانات التي يتحصّل عليها باستخدام تقنيات البحث العلمي. فيقوم هذا المنهج بعمليّات ثلاث هي: التفسير، والنقد، والاستنباط. فاختیرت روايتان «لیالي ألف لیلة» لنجیب محفوظ و«التیه» (من خماسیة مدن الملح) لعبدالرحمن منیف. فیبدو أن لهاتین الروایتین سمات خاصّة ومشترکة من حیث الأسلوب وطریقة الأداء في السرد؛ مثل استخدام طریقة السرد التقلیدي(حیث جاءت أجزاء الروایة مترابطة انطلاقاً من بدایة الروایة، فالعقدة، ثم الذروة، والحلّ، وأخیراً النهایة التي تختم بها الروایة)، الاعتماد علی شخصیات رئیسة ولا شخصیة واحدة، الاعتماد علی الحوار بین الشخصیات للکشف عن خصائصها ومستواها وطبیعتها واستخدام شخصیات الروایة إمّا من التراث التاریخي أو هي مستمدة من خیال المؤلف معتمداً علی واقع الحیاة في المجتمع، لغة السرد والوصف فصیحة ومتینة وبسیطة، استخدام تقنیة «الراوي العلیم» والرؤیة «مع»، وکذلک ضمیر «هو» لسرد الأحداث و...
كريمة نوماس محمد المدني،
المجلد ۱، العدد ۲ - ( ۱-۱۴۴۲ )
الملخّص
تكمن أهمية هذا البحث في السؤال عن كيفية دراسة الخصائص الأسلوبية في النص السردي الروائي العراقي. وستجيب عليها فقرات البحث في مفاصله المتنوعة ومجالات التطبيق من نصوص رواية خان الشابندر. لم يكن الفن الروائي بمنأى عما يمر به حال البلاد العربية، ولاسيما البلد العراقي من حالات الضياع وفقدان الأمن والاستقرار والتفرقة والطائفية والتهجير والقتل وهذا ما صنعته الحروب، وقد شغل الأخير مساحة واسعة من نفوس المبدعين العراقيين الروائيين الشرفاء بل ترك أثرا في نفوسهم ليمتزج ذلك الألم مع دم الأبرياء وحبر أقلامهم فانبروا يكتبون كل ما مر به هذا البلد من آهات وويلات فكانت أعمالهم الروائية محاكاة حقيقية للواقع بكل آلامه ومرارته وبشاعة القتل والرعب. فإن النص الإبداعي العراقي المعاصر وعى خطورة العنف بكل مدياته. وفي رواية خان الشابندر نجد مشاهد العنف متمثلة بواقع مرير يتجسد بمشاهد دامية من انفجارات الشوارع والبنايات المهدمة وانتشار الخوف والرعب والأشباح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة بغية الإخلال بالوضع الامني والاستقرار وممارسة أنواع القمع والقتل والتهجير وتصاعد إطلاقات النار والانفجارات المتتالية وكأن البلد أصبح ساحة حرب. وقد ارتأت الدراسة أن تكون على مدخل للتعريف بمفهوم العنف في اللغة والاصطلاح ثم دراسة إيقاع الأحداث والزمان في الرواية المذكورة، ثم تحاول الدراسة النسقية للصورة التركيبية للروایة التي تمثلت بنسقي الاستفهام والأمر و نسقي التماثل والاستبدال في الرواية. امتازت الرواية بكثرة حضور نسقي الاستفهام والأمر، فجاءت الأحداث مبنية على شعرية تساؤل درامي مشحون بالخوف والرعب مع أوامر حقيقية لذلك الحدث.
علي اسودي، سودابه مظفري، ماهرخ کوهر رستمي،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
یعد التحليل النقدي للخطاب من أحدث المناهج النقدیة، تأثر هذا المنهج من وجهات نظر میشل فوکو وفروید ومارکس فلسفيًا. إنه ينوي ربط الأشکال التعبیریة بالقضايا الاجتماعية ونقلها إلى النقطة المطلوبة.تعتبر مقاربة فرکلاف ذات المستویات الثلاثة من أوصاف وتفاسیر وشروح مفیدة وناجحة في هذا الجانب. من جانب آخر حاول القرآن الكريم تعديل الممارسات الاجتماعية من خلال استخدام الإشارات والرموز التعبیریة بشكل مجموعة ذات دلالة في مثل سورة الحجرات، ويمكن للباحث أن یتبنی نموذج فركلاف في دراسة السور القرآنية، فمن خلال تحليل البنية النصية مثل الكلمات والجمل على مستوى الوصف وتطبیقه علی السياق في مستوى تفسير الخطاب الحاكم، یقوم بشرح دور الجمل وعلاقتها بالخطابات الموجودة في المجتمع. تسعى هذه الدراسة معتمدة علی المنهج الوصفي التحليلي إلى توفير إطار لتحليل سورة الحجرات کخطاب قرآني وتوضيح وظيفته الاجتماعية في ضوء نظریة فرکلاف النقدية. وتشیر نتائج الدراسة إلی أن خطاب سورة الحجرات في المحور التربوي ینسجم مع الخطاب الموجود السائد في المجتمع ویحاول شرح نظام القيم الإسلامية.
فاطمة اکبري زاده، معصومه نغراوي،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
مثلت المرأة في المجتمع العربي والإيراني دورا بارزا في الأحداث الاجتماعية والسیاسية المعاصرة وذلك بناءً علی التطورات التي طرأت علی المجتمع الإيراني والعربي، بحيث أضفت هذه التطورات شخصيات بارزة من مثل شخصية "سيمين دانشور" وشخصية "رضوی عاشور" لتصبّ محاولة المرأة في المجتمعين لتصوير دورها دورا فريدا من خلال کتابة هاتين الکاتبتين في روايتي "سراج" لرضوی عاشور و"سووشون" لسيمين دانشور. ولهذا تطرّق البحث إلی معالجة تداخل الروايتين وإلی تناول الخطاب العام السائد علی الروايتين ليقف علی وجوه التداخل لدی الکاتبات في العالم العربي وإيران وعلی تداخل الخطاب المقصود لدی الکاتبتين "سيمين دانشور" و"رضوی عاشور" ناهجاً المنهج الوصفي التحليلي وذلك بناءً علی المدرسة الواقعية تبعاً لنهج الموازنة النقدية لتطرق المقاصد في الروايتين من حیث الخطاب. وتوصل البحث إلی أنّ الروايتين تتداخلان من حیث رصد المضامين الاجتماعية والأحداث الواقعية في مجتمعهما ولهذا الداعي أصبح الخطاب السائد یتجسد في الخطاب التاريخي، والعودة إلی التاريخ لرصد خطاب اجتماعي لتصوير دور المرأة في المجتمع الإيراني والعربي فيما أنّ الروايتين تزخران بمفردات وتعابير وأوصاف مکثفة تصور المرأة، وبرصّ المفردات والعبارات بحيث تمت المحاولة لإيحاء دور المرأة وبث صوت المرأة بواسطة الحوار الداخلي والاسترجاع الزمني انطلاقا من التاريخ، ولهذا کانت نهاية الروايتين تصب في الدور الريادي للمرأة بخطاب نسوي. وهذه المرحلة مرت عبر تجربة شعورية للکاتبتين بأحداث اجتماعية ووقائع سیاسية في بلديهما الإیراني والعربي لتعبير صادق یفي بالخطاب النسوي والتاريخي مرورا بالتراث.
أستاذ بروف نعمة دهش فرحان،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
حظيت قضايا السرد في الأدب العربي بنصيب وافر من البحث والتقصي والدراسة؛ وذلك لتعدد فنونه، وتفرعاتها، وتنوع تمثلاتها، ولاسيما تلك الفنون المضمرة في التعابير التناظرية، والمسكوكات اللغوية، كالقصة والحكاية اللتين تمثل أحداثًا واقعية اجتماعية، ينقلها المثل على نحو بناء تمثيليّ، وأداء تعبير، فسرد الأمثال قائم على تبادل الأفكار أو نقلها في الحوار عبر تمثلها، عند تحقق وحدة السياق في مناسبتين متشابهتين. يكشف العمل الأدبيّ عن جوهر شخصيّة منشئه من جهة، وعن ثقافة المجتمع الذي قيل فيه من جهة أُخرى؛ فليس من المعقول أن يكون (نهج البلاغة) قد ولد نتيجة اختراع فرديّ من دون اعتمادٍ على معطيات اجتماعيّة خاصة بالفرد والجماعة، ومن غير المعقول أيضًا أنَّ شكلًا أدبيًا كـ(نهج البلاغة) تميّز بهذا الغنى الاجتماعيّ، قد وجد وبقي قرونًا طويلة، ودرسه كتّاب وعلماء وباحثون، يختلف بعضهم مع بعض اختلافًا بالغًا، وينتمون إلى بيئات مختلفة، وإلى قوميات متباينة عبر قرون من الزمان، من غير أن توجد علاقة دالة بين مضمون هذا الشكل الأدبيّ وأكثر الجوانب أهمية في الحياة الاجتماعيّة. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث؛ للكشف عن قيمة كتاب (نهج البلاغة) بين سرديات المثاقفة وأعراف المجتمع، عبر دراسة عباراته المثلية، ومسكوكاته اللغوية التي نقلها الإمام علي (ع) بخبراته وتجاربه من المجتمعات السالف إلى المجتمع الذي يعيشه، فجاء البحث في مبحثين: أولا المثاقفة الاجتماعية وسرديات الرمز اللغويّ وثانیا الاعراف والعادات والتقاليد المضمرة في الاستعمال العلويّ. والجدير بالذكر أنَّ البحث قد سار على وفق المنهج التاريخيّ، مع اشمام المنهجين السياقيّ والوصفيّ التحليليّ. وخرج بجملة من النتائج، اهمها:
۱. يستطيع الفرد المُبدع الوقوف على بنية الذات الجمعيّ أن يتأمل المواقف والأحداث، وأن يختار ما يريد من المقولات الاجتماعيَّة التي تشع من أفق ذلك المُبدع من حيث إنَّ المُبدع العبقريّ يُعدُّ في طليعة الأفراد الذين يحاولون تكوين ذات جماعيَّة تتجاوز الذات الفرديَّة.
۲. تمثلت الأعراف والتقاليد والعادات في أسلوبية النهج بالعبارات المثليّة، هي من مخترعات المجتمع العربيّ الجاهليّ، وهذا يدلُّ على تأثر لغة نهج البلاغة بتلك المواقف والأحداث، حتى أصبح نهج البلاغة سجلًا صادقًا لتاريخ القبائل العربية قبل الإسلام وبعده، بل مثّل نهج البلاغة سجلاً سرديًا لحضارات أُمم خلت قبل ظهور المجتمع العربيّ.
نور الحنيلة بنت محمد اسماث، عبد الهادي بن عبد العزيز عبد العزيز، نور زينية نوريتا مختار، أرينا جوهري،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
الملخص
بما أنّ الصّور البيانية من تشبيه، مجاز، استعارة، وكناية، تسعى إلى التّاثير في المتلقّي وتمكين المعنى في ذهنه، يمكن القول إنها ذات أبعاد تداولية. لقد حقق هذا البحث في مقامات الزمخشري بمنهج وصفي -تحليلي کی یکشف عن ملامح التداولية التي تمثّلت وسائل الانسجام في علم البيان عبرعملية التفكير والتأويل. بعبارة أخری یتناول البحث التّراث اللغوي العربي ومحاولة ربطه بمعطيات النّظرية الغربية وفق مفهوم نحو النّص بما يتناسب فيه مع مقامات الزّمخشري. ممّا يلاحظ في هذه المقامات، أنّ التّماسك النّصّي يستجلي بوضوح، فقد وظّف الزّمخشري وسائل الانسجام توظيفًا جيّدًا، فنسج مقاماته بشكل متماسك، فتتحقّقت نصّيّة النّص بظهور هذه الوسائل. فبرز في تحليل المقامات أهمّيّة دور المتلقّي في تحليل النّص وفكّ عناصره بوساطة إدراكه للغة النّص وسياقه. بيّنت الدّراسة العلاقة الوثيقة بين التّراث العربي ونحو النّص، وهذا ما لمسناه من مساهمة علم البيان بعدّة وسيلة من وسائل انسجام النّص.
شکوه السادات حسیني، زهرا محمود آبادي،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
إنّ تدفّق التكنولوجيا إلى حياة الإنسان في العصور المتطوّرة والوتيرة المتسارعة لظواهر ما بعد الحداثة في الآونة الأخيرة جعل التساؤل عن الهوية والانتماء الفردي واحدا من أصعب التحدّيات التي تواجهها القضايا الاجتماعية في النصف الثاني من القرن العشرين. وإبراهيم نصر الله الكاتب الفلسطيني الشهير، تمكّن من الولوج إلى هذا الموضوع من خلال الأدب وبنظرة جديدة. فقد وظّف عنصر الخيال في حقل الواقعية السحرية، فصوّر مستقبل البشر في ظلّ الرغبة المتنامية للمحاكاة وصناعة النظائر؛ الظاهرة التي تجلّت في مظاهر مختلفة ووسيعة وسبّبت في إزاحة الانتماءات الفردية. وما هذه الرواية إلّا تحذير من ظهور هذا المفهوم المستعار الذي إن كتب له الاستمرار في الجوانب الحقيقية للحياة الإنسانية فمن شأنه أن يشعل فتيل حروبٍ ونزاعات من نوع جديد، ويفرض العنف المدمّر على المجتمعات البشرية. وقد تطرقت هذه الورقة إلى أجواء الواقعية السحرية فيما تسرده رواية حرب الكلب الثانية عن الهوية الفردية، مستخدما المنهج الوصفي-التحليلي، ليدرس أزمة الانتماء الفردي في حركة المرء من سلوك فردي محض إلى كارثة إنسانية مدمّرة.
لارا نبهان ملّاك،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
يدور هذا البحث حول فكرةٍ مركزيّةٍ أولى هي السّردانيّة في قصائد الشّاعر بدر شاكر السّيّاب، وعلى وجه الخصوص في قصيدته "قافلة الضّياع". وتتجلّى أهمّيّة البحث في كونه يتناول لغة شاعرٍ عربيٍّ ذي شهرةٍ واسعة، ويتناول السّردانيّة بوصفها أسلوبًا متاحًا في الشّعر الحديث. والهدف من ذلك ليس فقط الإضاءة على الشّاعر أو على شعره أو على الحقبة الزّمنيّة الّتي عبّر عنها، إنّما بالإضافة إلى ذلك التّوصّل إلى تصوّرٍ يحدّد للقارئ الفروقات والحدود الّتي لا بدّ أن تميّز اللّغة الشّعريّة عن اللّغة السّرديّة. ويكون ذلك من خلال تتبّع الأسلوبين في النّصّ الواحد على الرّغم من تداخلهما خدمةً للإبداع وللمعنى. أمّا في منهجيّة الدّراسة، فيعتمد البحث الألسنيّة السّلوكيّة – التّوزيعيّة الّتي أتى بها العالم اللّغويّ الأميركيّ بلومفيلد، وطبّقها في نصوصٍ سرديّة. ويبرز هذا المنهج قادرًا على تحقيق غاية البحث، فنرى التّوزيع عاملًا مهمًّا في سبك العنوان، كما نرى التّرتيب السّلوكيّ أساسيٌّ في المسار الدّلاليّ المطروح. وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوّة ضمن المنهج المعتمد، جاءت عناوين البحث الأساسيّة: ۱ العنوان، ۲ الأفعال (دراسة سلوكيّة)، ۳ القصص الدّينيّة والتّاريخيّة، ۴ الحوار.أمّا في النّتائج، فقد أظهرت هذه الدّراسة المختصرة ارتكاز القصيدة على السّردانيّة والشّعريّة معًا. على المستوى السّرديّ لم تغب عناصر النّوع القصصيّ بأغلبها، وهي الأحداث، والإطار الزّمانيّ المكانيّ، والشّخصيّات، والحوار، والصّوت السّرديّ. وعلى المستوى الشّعريّ لم يبخل الشّاعر بالرّمزيّة وبالمجاز. بَيْد أنّ الفصل بينهما يكمن في الفصل بين الواقع والمتخيَّل، فيتأرجح التّعبير بين نقل الواقع الحقيقيّ واختلاق الصّورة الشّعريّة النّاطقة بتفاصيل العالم النّفسيّ الصّارخة. وهذا يُفضي إلى ترابطٍ بين الاثنين وتأثّرٍ وتأثير، فالواقع هو الضّاغط على الحالة النّفسيّة حتّى تفجّر العاطفة، والعاطفة تصوّب قوّتها نحو العالم كي تؤثّر فيه. وقد تكون الغلبة لأحد الأسلوبين على حساب الآخر في بعض جنبات النّصّ، لكن يبدو أنّ كلًّا منهما وسيلةٌ وغاية في آنٍ معًا.
زیبا بهاري نوران، دکتور عبدالله حسیني، أستاذ بروف حامد صدقي،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
ما بعد الاستعمار هو مصطلح دأب المؤرخون علی استعماله في المرحلة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة لإظهار الحقبة التي تلت استقلال معظم دول العالم عن الاستعمار الغربي الحدیث. یعد خطاب ما بعد الاستعمار من ثمرات نظریة ما بعد الاستعمار التي ابتکرها إدوارد سعید وهي من النظريات الأدبیة المعاصرة التي تتعلق مهمتها بتنظیر قضایا المستعمَر والمستعمِر. المشكلة الرئيسية التي يسعى الباحثون لحلها هي كيفية انعكاس خطاب ما بعد الاستعمار في رواية دفاتر الطوفان وماهية القضايا التي يمثلها هذا الخطاب في المجتمع العربي خاصه المجتمع الأردني. نستهدف في هذه المقالة مناقشة إحدی الروایات العربیة الأردنیة المعاصرة المکتوبة في هذا المضمار وهي "دفاتر الطوفان" لسمیحة خریس معتمدین علی الأسلوب الوصفي التحليلي مستعینین بنظریة إدوارد سعید لاستکشاف ملامح ما بعد الکولونیالیة فيها. لقد استنتجنا أنّ المؤلفة أشارت بشکل دقیق وفني إلی إشکالیة ما بعد الاستعمار في المجتمع العربي بلسان الأشیاء والجمادات المختلفة واهتمّت بصورة سویة بجمیع ملامح مابعد الاستعمار المطروحة في أثرها الروائي ولم ترجح واحدة علی الأخری، واستخدمت مکونات ما بعد الاستعمار في الشؤون العامة المألوفة للحیاة العربیة، وأشارت بصورة فنیة إلیها. ثم أن خریس تعکس في "دفاتر الطوفان" بعض الخصائص ضد الاستعماریة من أمثال مواجهة الهيمنة الغربية والمرکز والهامش والجنسیة والحریة والاستقلال ببراعة خاصة.
د.خديجة مرات،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
يشغل الخطاب الحجاجي حيّزا كبيرا في النص القرآني بشكل عام وسورتي البقرة وطه بشكل خاص، ويتجلى ذلك من خلال تعدّد الموضوعات التي تطرّقتا إليها وتنوّع المخاطَبين فيهما؛ هذا ما أدّى إلى توظيف كثير من الآليات الحجاجية: لغوية، وبلاغية... بقصد جذب انتباه المخاطبين من أجل الامتثال والاقتناع بما أُمروا به، ومن أجل ذلك، جاءت هذه الدراسة معتمدة على منهج وصفي تحليلي وبالاستعانة بالمقاربة التداولية لتسلّط الضوء على آليات الحجاج والإقناع في سورة البقرة وسورة طه؛ ذلك لأنّ غايتهما حمل الطرف المتلقي على الاقتناع بالتسليم والإذعان لله تعالى. من خلال عرض آيات الحجاج والحوار التي دارت بين المرسل والمتلقي، ورصد الأفعال الكلامية والروابط الحجاجية لتحقيق استراتيجية الإقناع المنضوية ضمن الحقل الكبير المعروف باستراتيجيات الخطاب نتناول هذه القضايا اللسانية التي تعني أن الخطاب المنجز يكون خطابًا مخططًا له بصفة مستمرة،إذ يعمد المرسل في خطابه إلى توظيف استراتيجية مناسبة تعبر عن مقصده وتحقق هدفه على حدّ تعبير عبدالهادي بن ظافر الشهري، وهي استراتيجية تداولية، تكتسب اسمها منهج الخطاب، ويبني فعل الإقناع وتوجيهه دومًا على افتراضات سابقةبشأن عناصر السياق خصوصًا المرسل إليه، وتستعمل هذه الاستراتيجيةمن أجل تحقيق أهداف المرسل.
د. أيمن أحمد علي عبد اللطيف العوامري،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
يستهدف هذا البحث بيان جماليات تقنيات إبطاء السرد في القرآن الكريم؛ متخذًا من سورة يوسف نموذجًا للتطبيق، ويتحرى البحث كشف اللثام عن جماليات استعمال القرآن الكريم تقنيات الحوار والوقفة، وتوظيف ذلك فنيًّا ودلاليًّا، ومدى تأثير ذلك في البناء القصصي، والآفاق الدلالية التي يفتحها ذلك التوظيف بما يتجاوز حدود السرد.يكتسب هذا البحث أهميته من كونه يتخذ من القرآن الكريم مادة لتطبيق المفاهيم والنظريات السردية النقدية، ولا شك أن ذلك يعطي الدراسة عمقًا وأهمية كبرى لا يمكن أن يمنحها أي نص آخر، كما أن أي دراسة تتعلق بالقرآن الكريم فهي دراسة تتسم بالخلود والبقاء؛ إذ تستمد بقاءها من الذكر الحكيم الذي حفظه الله -سبحانه- على مر العصور وكر الدهور.تُعَدّ هذه الدراسة ضرورية؛ لأن وقوع القصص في القرآن الكريم يثير إشكالية مفادها: مدى إمكان تطبيق النظريات النقدية على القرآن الكريم بوصفه نصًّا يتسم بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة بغض النظر عن قائله العظيم -سبحانه.استند الباحث إلى المنهج الوصفي التحليلي الذي يرصد الظواهر التقنية لإبطاء السرد في سورة يوسف؛ بغية الوقوف على توظيف تقنية الوقفة، والحوار في بنية السرد، وتحليل هاتين التقنيتين؛ بغية الوصول إلى نتائج موضوعية.توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج؛ لعل أهمها: كان لتقنية الحوار حضور كبير جدًّا في سورة يوسف؛ حتى إن الآيات الحوارية بلغ عددها إحدى وسبعين آية من مجموع ثمان وتسعين آية هي عدد آيات السورة وقد كان لهذه التقنية توظيفها الفني والدلالي الفريد. وأخيرًا، من خلال دراسة تقنيات السرد في هذه السورة وجدنا أن استخدام هذه الأساليب، بما فيها تقنية إبطاء سرعة السرد في سورة يوسف، تسبب توازنًا دلاليًا فيها.
سمانه موسی بور، یوسف هادی بور،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
الانطباعية مدرسة أدبية فنية، ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا تعتقد أن الإحساس والانطباع الشخصي هما الأساس في التعبير الفني والأدبي. ويرجع ذلك إلى أنّ أي عمل فني لابدّ من أن يمرّ بنفس الفنان، وعملية المرور هي التي توحي بالانطباع الّذي يدفع الفنان إلى التعبير عن نفسه. تؤكّد هذه المدرسة الفنية، مسـرحية الضّوء والظّل على إدراك اللّحظة وتسجيلها، والذّاتية، وغموض الصورة، والتّوهج غير المستقر للألوان والمزج مع الرّمز في العمل الأدبي. سناء الشعلان كاتبة فلسطينية نشرت رواية «أدرکها النسیان» بعناصر من الخيال الانطباعي وحصلت على جائزة نجمة السلام العالمية. تظهر التأملات في العناصر الانطباعية في أعماق القصة أنّ الشعلان رسمت لوحات للواقع والخيال، وتوجّهت إلى السّلام والعدالة والحريّة في العالم؛ وقد رسمت قضايا إنسانية مهمة؛ مثل الحرب والإزاحة والفقر والحب والصَّحوة منعكسة في صورة حياة الإنسان. يستهدف هذا المقال تحليل المكوّنات الانطباعية بطريقة وصفية تحليلية، معتمدة على نظرية «سوزان فيرغوسن» لخصائص الرواية الانطباعية، و تحاول نقد وتحليل رواية «أدرکها النسیان» و إبراز جوانب النّظرية الانطباعية فيها. أظهرت النّتائج أن الرواية هي مثال ناجح للأدب الروائي يسمى «الانطباعية» في الأدب الروائي العربي. ثم تقدم مؤلّفة الرواية سردًا غامضًا من القصة مستندا إلى نموذج «سوزان فيرغوسن» مستخدمة تجليات الانطباعية مثل الحبكة المحذوفة، والحبكة المجازية، وانقطاع الوقت و السرد في الرواية، والدور الاستعاري للمكان مما أدّى إلى إنعكاس في الأفكار والمشاعر الدّاخلية لشخصيات القصة، والمشاعر والعواطف الغامضة والمتقلبة والمتغیرة الدّاخلية لشخصياتها.
كريم الطيـبـي،
المجلد ۲، العدد ۱ - ( ۷-۱۴۴۲ )
الملخّص
تهدف الدّراسة إلى رصد طبيعة السّرد العربي القديم معتمدة علی أساس المنهج التحلیلي، من خلال دراسة السمة الموسوعيّة التي تطبع النّصوص النثرية العربيّة القديمة بشكل لافت، مؤشّرة على الخصوبة المعرفيّة ووفرتها، وامتداد أطراف العلوم وتشعّبها لدى ثقافة الأديب العربيّ، وقد تتبّعنا هذه السّمة في كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حيّان التّوحيدي باعتباره خطابا قائمًا على السّرد الموسوعيّ، لنتعرف تجلّياتها وأشكالها ووظائفها. هذا الکتاب هو الذي يترحّل فيه مؤلّفه في ضروب المعارف وأصناف المجالات العلمية مستحضرا مختلف الأجناس التعبيريّة والأنماط القوليّة، الأمر الذي يدفعنا إلى الإقرار بأن النثر العربيّ القديم نثر يقوم على الإمتاع والإنفاع. وجدير بالذكر أن صورة المتكلِّم الموسوعيّة وإن كانت ملمحًا يطبع نثرَ التَّوحيدي جميعه، فإنها في إطار المسامرة ارتبطت بوظيفة تأثيريّة تداوليّة، إذ رام المتكلم أداء وظيفتيه التثقيفية والامتناعية اللتين أنيطتا به، وذلك حتى ينال رضا الوزير ابن سعدان، ويحقق الحظوة في مجلسه، وتقربنا أحد الملفوظات من هذا الملمح. أما الخطاب السّردي في الإمتاع يبرز ذاتا متكلمة موسوعية تتنقّل بين العلوم، وتصول بين المعارف، ولا تتردّد في التَّفاعل مع أسئلة الوزير ابن سعدان.
حامد صدقی، سید عدنان اشکوری، پوران رضائی چوشلی،
المجلد ۲، العدد ۲ - ( ۲-۱۴۴۳ )
الملخّص
تمثل السردية انجازا لتطور المناهج البنيوية في عصرنا الحالي ويمثل الفرنسي جيرار جينيت أحد أبرز السرديين الذي تحظى آراؤه بإهتمام جل الباحثين في مجال الأدب، وقد حظيت مؤلفاته الادبية التي كتبها للكبار بالتحليل السردي لكنه قلما حصل إهتمام مماثل بقصص الاطفال ومما لاشك فيه فإن التحليلات الادبية لقصص الاطفال يمكنها التعريف بالابعاد المختلفة لنص القصة المخصصة للطفل والإضاءة على الشرائح الخفية لنصوص تلك القصص. وفراشة الأمیرة الحمراء، هي قصة مؤلفة من وحي الخيال العلمي ألفها الكاتب المصري نبیل خلف عام (۲۰۰۴م). والبحث الحاضر بصدد استعراض اسلوب الوصف التحليلي من خلال الاستعانة بمصادر المكتبات وتطبيق منهج جيرار جينيت السردي على قصة فراشة الاميرة الحمراء.وتُبين نتائج البحث لنا أن الكاتب إستعان بادوات القصة الداخلية والخارجية في سرد جذاب لهذه القصة. لكننا نلاحظ إن عنصر الزمان في هذه القصة، لم يطوي مسیره الخطي لذلك نشاهد اضطراب الزمان في بعض أقسامه بصورة جلية، ومن حيث المداومة، نلاحظ وجود زمان مضغوط في ۱۵ قسما من اقسام القصة،كذلك فإن وجه القصة حافل باجواء عاطفیة من فرح وحزن وخوف تُلهِم أحاسيس الطفل، وبعد دراسة القصة بصورة سردية، يخلص المؤلفون الى هذه النتيجة وهي أن قواعد السردية لم يُهتم بها لدى كتابة قصة فراشة الأمیرة الحمراء والحال إنها قصة جذابة ومناسبة للأطفال.
أ.بروف.د. صبحي البستاني،
المجلد ۲، العدد ۲ - ( ۲-۱۴۴۳ )
الملخّص
إن النقد الجامعي أو الأكاديمي هو في سباق مستمر مع النتاج الأدبي، إذ يسعى دائما إلى تصنيفه وتأطيره وتحديده. ولكن التبدل السريع الذي يحدث في المجتمع على مختلف المستويات يجعل الأطر والحدود باطلة ولو جزئيا. وإذا نظرنا إلى الرواية كنوع أدبي، وبالرغم من أن الحرية والانفلات هما من طبيعتها أصلا (Robert,۱۹۷۲ :۲۴)، نرى بعضا منها يتخطى في القرن الحادي والعشرين كل المقاييس التقليدية. فقد اتخذت مثلا وسائل التواصل الحديثة من إنترنيت وفايسبوك وسواهما دورا مهما في ميدان الإبداع الأدبي، وبتنا نقرأ مثلا رواية كرواية عشيقة آدم للكاتب التونسي منصف الوهايبي والتي يصفها المؤلف "بالراوية الفايسبوكية" حيث لا سرد فيها وإنما هي حوار على الفايسبوك بين رجل وامرأة، "حوار الأصابع"، كما ينعتها أيضا المؤلف. وهناك غيرها من الروايات )جرجور،۲۰۱۶) فتطرح جديا إذاً مسألة الحدود بين الأنواع الأدبية بشكل يتجاوز نظرية "عبر النوعية" لأدوار الخراط (الخراط،۱۹۹۴).
وفي هذا الخضم من اضطراب المقاييس، يشهد الحقل الأدبي العربي، وفي مجال الكتابة الروائية أيضا، مبادرات تجديدية أخرى، جاءت كردة فعل مباشرة أو غير مباشرة على الأحداث التي يعيشها العالم العربي في هذا العقد الأخير، أي قبيل ما يسمى "بالربيع العربي" وبالفترة التي تليه. ومن هذه المبادرات ما يتجاوز البنية التقليدية للرواية ويحطم الترتيب الزمني والتسلسل التاريخي ويلغي الحدود بين الواقع والفانتازيا فيدخل "الخيال العلمي" كعامل مباشر في بناء السرد وتطور الاحداث. فهي، وإن غاصت في الماضي أحيانا، مستلهمة التراث، فإنها في الوقت نفسه تستشرف المستقبل. وفي هذا السياق تقع الكتابة الحديثة التي تنتمي إلى تيار اليوتوبيا والديستوبيا Utopie et Dystopie. ومن الروايات العديدة التي سارت في هذا التيار سنتناول في بحثنا روايتين: "يوتوبيا" لأحمد خالد توفيق الصادرة سنة ۲۰۰۸، و"عُطارد"لمحمد ربيع الصادرة سنة ۲۰۱۵. ترمي هذه المقالة إلى تحليل التقنية الروائية التي تتخطى تراتبية الزمن في السرد من جهة، وتخلق عوالم تزول فيها الحدود بين الواقع والفانتازيا من جهة ثانيةعلی المنهج الوصفي التحلیلي كما أنها تحاول أخيرا الربط بين هذا النوع من الكتابة والوضع السياسي الاجتماعي المضطرب الذي يعيشه المجتمع العربي.
دکتورة ريمة لعواس،
المجلد ۲، العدد ۲ - ( ۲-۱۴۴۳ )
الملخّص
تعيش الكتابة النسائية اليوم مرحلة جديدة من التعبير الإبداعي سواء من حيث النوع أو الكم، الأمر الذي يستدعي منا المساءلة والمتابعة النقدية الجادة، وإن كان تعاطي الكتابة النسائية ليس بالأمر الهين لا سيما في العالم العربي نظرا لعدم رسوخ التصورات المنهجية في المعالجة النقدية للأدب النسائي، إضافة إلى ارتباط العملية النقدية بما يسمى بالهوية الجندرية، الأمر الذي يتطلب من الناقد أن يكون حذرا وهو يسير في هذا الدرب الوعر إذا أخذنا بعين أن الناقدات المنحازات إلی النسوية يستبعدن البراءة عما يكتبه الرجل، وأن معظم الجهود النقدية التي بذلها الرجال حول النصوص الأدبية النسائية لا تخلو من دس ذكورية، فهل الحقيقة كذلك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه معتمدا علی المنهج الوصفي التحلیلي من خلال هذه الورقة التي تسلط الضوء على جملة من المسائل النقدية التي طرحها النقاد الرجال في العالم العربي من قبيل: الكتابة بالجسد، وكسر التابو الجنسي، طرح القضايا النسوية، ميثاق السيرة الذاتية.
دکتور غلامرضا کریمي فرد، بروین خلیلي، دکتور مسعود باوان بوري،
المجلد ۲، العدد ۲ - ( ۲-۱۴۴۳ )
الملخّص
اليوم أصبح النقد النفسي جزءا لا يتجزأ من الأدب. ولفهم النص الأدبي بشكل صحيح، يقتضي بالضرورة، الحديث عن الحالات النفسية والوجدانية للكاتب ويتم تحديده في سياق كلمات وسلوك شخصيات الرواية لذلك، لفحص عقلية الكاتب وحالاته النفسية والروحية، يجب علينا أن نفحص كيف يتم التعبير عن أفعال وكلام الشخصيات خلال الرواية. من أشهر علماء النفس "سیغموند فرويد" الذي يؤمن بوجود ثلاثة أقسام للجهاز النّفسي؛ هي الشّعور وما قبل الشعور واللاشعور. والقسم الثالث يحتوي على الدوافع الغريزية البدائية الجنسية والعدوانية؛ أي أنّ الحياة النفسية مكوّنة من الأنا، الهو، والأنا الأعلى وهو يلعب دوراً هاما في تكوين حياة الفرد. تعتبر رواية "لعبة النسيان" من أهم أعمال الكاتب محمد برادة (۱۹۸۷م.) التي هي موضع دراستنا في ضوء النقد النفسي حسب نظرية فرويد- ومتمسكا بالمنهج الوصفي – التحليلي. وقد أوحی بعض النتائج من خلال هذا البحث على أن يتحدث محمد برادة في روايته عن الألم والصراع النفسي بين الناس والمجتمع. الموضوع الرئيس للرواية هو حالة بعض أفراد الأسرة النفسية بعد وفاة والدتهم والمشاكل والمصاعب التي يواجهونها في مجتمعهم. ونرى من خلال التحليل النفسي أنّهم يعانون من الكآبة والحزن والصراع النفسي والحنين إلى الماضي. يعد الصراع النفسي والشعور بالنقص والنوستالوجيا والحب والأحلام من أهم الأغراض النفسية في الرواية ويصوّر الراوي حياة شخصيات مجتمعه من خلال هذه الأغراض. توجد داخل الشخصيات العقد والأمراض والآلام بسبب مصائب الحياة أو نتيجة ندم على خطاء يرتبكونهم.
دکتور علي كاطع خلف،
المجلد ۲، العدد ۲ - ( ۲-۱۴۴۳ )
الملخّص
تسعى هذه الدراسة إلى البحث في رواية الرجل الآتي للروائي العراقي د.عبدالهادي الفرطوسي من خلال احد أهم عناصر البناء الفني في الرواية ونعني به الشخصية ولكن ليس الشخصية عموما وإنما الشخصية البطولية أي البطل تحديدا لعدة أسباب لعل أهمها: أولا: عنوان الرواية وما يحمل من دلالات لا تخفى على القارئ ولاسيما في العراق، ويمكن القول بعبارة أخرى إن الرواية هي التي فرضت عنوان هذه الدراسة ومنهجها. ثانیا إن الرواية كتبت ونشرت قبل الاحتلال، أي في وقت كانت الرقابة على المطبوعات في أقصى مداها، بيد أنها لم تنشر في العراق وإنما نشرت في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.و ثالثا: إن الرواية قد فازت هناك بجازة الإبداع الروائي.
يدرس الباحث في هذه الدراسة رواية الرجل الآتي بمنهج وصفي تحليلي. أظهرت أهم نتائج البحث أن سبب تسمية الرواية "بالرجل الآتي" هو أن هذا الشخص هو الرجل الذي ينتظره الوقت وله خصائص معينة، ربما إذا لم نستطع أن نقول بشكل قاطع أن الانتظار كـ مخلوق ثابت في هذه الرواية هو موجود في المكان والمكان وحتى الزمان، مخلوق تتجلى رجولیته الحقيقية في حضوره وظهوره في هذه الرواية ، وتتفكك الرجولیة السابقة التي هي نوع من الرجولية الفارغة.
دکتورة كيّسة ملاح،
المجلد ۲، العدد ۲ - ( ۲-۱۴۴۳ )
الملخّص
ترتبط الرواية منذ نشأتها بهاجس ضرورة استجابة الكتابة لسؤال الحرية ولمعطيات العصر، وقد حاولت هذه الرواية بلورة عدة مفاهيم كالحرية والمتخيل والمجتمع والهوية... كما رفضت الرواية العربية أن تعيش على الهامش بلا حياة، وتحولت إلى صمام أمان يحمي الأمم من السقوط في هوة النسيان، ففي عالم متناقض وصعب تُصبح الحرية هاجس الأدب ومبتغاه وتصبح الهوية هاجس الأديب وبحثه الدؤوب.
ويتعلق السؤال هنا تحديدا بتحديات الرواية العربية وقضايا الهوية والحرية والتاريخ، فهل هي ضرورة حضارية للحرية؟ وهل تنشأ داخل الحاجة الثقافية التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها وجه الآخر الثقافي أمام عالم متحول ومنزلق؟ وهل هذه الرواية هي التاريخ المضاد للتاريخ الذي تصنعه المؤسسات الرسمية وهو تاريخ طوباوي مليء بالأكاذيب؟ فهل للرواية القوة من أجل قول تاريخ مسكوت عنه، والحفاظ على جسورالحوار التي تضيق كل يوم قليلا. تسعی هذه المقالة دراسة قضایا ثقافیة مترکزة علی المنهج الوصفي التحلیلي في روایة أکراد أسیاد بلا جیاد. إن رواية "أكراد أسياد بلا جياد" نموذج لسرديات الهوية القومية، وكما يشعر الأكراد بالأسى كانت الرواية كذلك تعبر عن مدى الألم والأسى الذي يشعر به كل كردي ومدى الألم المعبر عنه، ورغم السرد البطيء للرواية، ورغم أن لغتها تخلو من أي حشو وأي إضافات شعرية، وتظهر أحيـــــــــــانا مملة وصعبة القراءة، إلا أنه هناك رابط خفي بين السطور يقود القارئ إلى آخر الرواية، رواية تعبر عن مصير شعب اضطهده العالم ونسيه التاريخ، يجد القارئ نفسه وهو يتتبع خطـــــــــــــوات البطـــــــــــــل في بحثه عن صديقه شيروان، ويتتبع القارئ هوية قومية بحاجة الى تعريف من جديد.
طاهره حيدري، أستاذ دکتور محمد علي آذرشب،
المجلد ۲، العدد ۲ - ( ۲-۱۴۴۳ )
الملخّص
هذه المقالة تدرس سرعة السردیة في رواية الزمن الموحش وفق نظریة الناقد الروائي جيرالد برینس. وهدفنا ، هو دراسة العلاقة بين زمان الرواية التي -تقاس بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات – وبين طول نص القصة الذي يقاس بالسطور والصفحات والفقرات . عملت رواية الزمن الموحش من تأليف الكاتب السوري حیدر حیدر، على تحليل قيم وتقاليد المجتمع ورسم ملامح الشخصيات التي قطعت إرتباطها بالتقاليد الماضية فظهر عليها العجز و الهزيمة والموت و أفرزت أشخاصا ثوريين وأنانيين وملاحدة وعدميين ومزعجين. وقعت أحداث هذه الرواية في غضون ثلاثة أعوام وما عدا بعض التلميحات الى عدد من فصول السنة ، لن تجد فيها أية إشارات الى الزمن الدقيق الذي يحدد متى وقعت تلك الأحداث. وأما علاقات الزمان والعلة والمعلول في هذه الرواية فهي ضعیفة لكن الذي يمنح الوحدة لهذه الرواية هو نفس الراوي/ باعتباره الشخصیة الاصلية فضلا عن وحدة المکان. هذه الرواية ليست لها بداية ونهاية منظمة ومرتبة بل تجد كل شيء فيها متشابكا ولايمت بصلة الى بعضه البعض . وكذلك أحداث الرواية، فهي متفرقة. وكما تسعى هذه الرواية للقضاء على الشئون القديمة، لماضي العرب وللانسان العربي وأواصره القديمة في مجالات الشکل والأساس فهي أيضا تحاول القضاء على تقاليد الرواية في مجالات الاُسس الزمكانية والأحداث والشخصیات. وضمن تمتعها بالمقترحات السردية الكثيرة فإنها إستفادت من المجموعات الخمسية لسرعة الروایة أيضا. وخلال هذا البحث، تجري دراسة سرعة الروایة والتغییرات التي تعتورها من حيث الإسراع والتباطؤ وهذه الدراسة تفيد بأن الكاتب إستفاد بشدة من تقنيات التداخل بین المشاهد، ومن ظاهرة التناوب والتضمین وسبل تقليل السرعة السردیة.
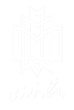
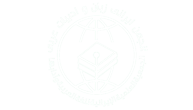
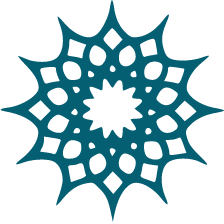

.png)
